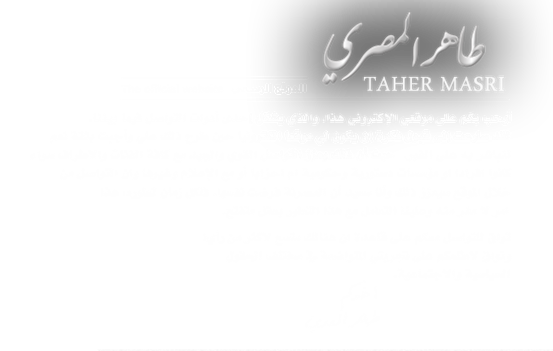

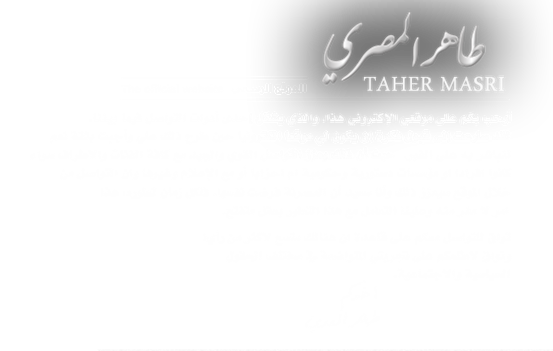

سياسي يتذكر الحلقة الثالثة
22 نيسان 2014
المصري: عندما سمعت باندلاع حرب حزيران حمدت الله
محمد خير الرواشدة
عمان-بعد أن وصف رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري عمق العلاقة التي كانت تربط الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول بعائلة المصري في نابلس، وتفاصيل آخر زيارة قام بها الشهيد لدار الحاج معزوز المصري، قبل يوم من استشهاده على بوابة الأقصى.
وبعد أن وصف المصري مظاهر القمع للمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية ضد انضمام الأردن لحلف بغداد، وتعامل الحكام العسكريين مع أي نشاط سياسي له اتصال بالأمر، وتبعات ذلك على عائلة المصري، وبقاء أعمامه قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.
يواصل المصري في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات "سياسي يتذكر"، سرد ذكرياته، حول مرحلة الدراسة الجامعية، التي بدأها في بيروت لمدة عام، قبل ان يغادر إلى الولايات المتحدة ليدرس الإدارة العامة.
ليعود ويشارك في تأسيس البنك المركزي موظفا لنحو سبع سنوات ونصف، ويتزوج سمر ابنة الطبيب في الخدمات الطبية الملكية اللواء سعد البيطار.
ويتوقف المصري اليوم عند انطباعاته الانسانية والسياسية لحرب حزيران 1967، وكيف عاش حلم الانتصار بالحرب، قبل ان يستفيق كما جيله، على انتصار العدو واحتلال الضفة الغربية، والجولان وقطاع غزة وسيناء، ويستذكر كيف بكى "كالاطفال" عندما استمع لخطاب استقالة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي حمّل فيه نفسه اسباب الهزيمة "النكسة".
من هناك، بدأ المصري يشعر بالغربة بين الضفتين، وانقطاعه عن عائلته في نابلس، ويروي قصة زيارته لنابلس بعد الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، حيث عبر الحدود تهريبا، ليطمئن على أحوال أسرته، ويكشف عن صدمته الأولى بوجود الجندي الإسرائيلي في أرض نابلس.
كما يقدم المصري رأيه بأحداث أيلول من العام 1970، ويؤكد بأنها "لم تكن حربا أهلية"، فالحرب الأهلية؛ برأيه، هي بين مكونين شعبيين في ذات البلد، ويُجر لها المدنيون عنوة، ويكونون ضحايا لها.
ويزيد المصري بأن "أيلول" لم تكن كذلك، بل كانت مناوشات بين أحزاب سياسية تحمل السلاح، وتريد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبين الجيش والأمن الأردني، الذي رفض مظاهر حمل السلاح في الشوارع، واستمرار مظاهر الانفلات الأمني.
ويُعلن المصري موقفه من الأحداث بالقول: أنا شخصيا كنت وما أزال مع النظام العام، الذي يحمي الجميع من الخطر، ويحصن المدنيين من أي شعور بالخوف أو بعدم الاستقرار وغياب الأمن، فالأمن والسلم الأهليين ضمانة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وفيما يلي التفاصيل...
نهاية العام 1959 حملتك إلى الدراسة الجامعية والسفر بعيدا عن نابلس؟
سافرت إلى الجامعة الأميركية في بيروت، ولم أكن راغبا في ذلك، لكن والدي كان مصرا، ومع ذلك لم ينته حلمي بالسفر لأميركا والدراسة فيها.
بعد سنة من الدراسة في بيروت، تمكنت من إقناع والدي بالذهاب للدراسة في أميركا، وأقمت فيها أربع سنوات كاملة، دون أن أعود بأي زيارة لنابلس، وكانت هذه فترة بيات سياسي، فوقتها كانت الاتصالات شحيحة ووسائل الإعلام بالكاد تركز على القضايا في الدول البعيدة.
طبعا، عند مغادرتي إلىأميركا، طرت من مطار قلنديا، إلى بيروت، ثم من هناك إلى مطار امستردام، ثم وصلت مطار دالاس في تكساس، لأركب بعدها الحافلة حتى وصلت قرية دنتون، التي أقمت فيها أربع سنوات دراسية كاملة.
وهل كانت الحياة هناك سهلة؟
كانت سهلة وممتعة، أهم ما كان فيها، أنك تطّلع على ثقافة الآخر وتتعلم نمط حياة مختلفا، كان هذا الأمر وحده درسا مهما لي في الحياة.
كان والدي يحول لي مصروفي الشهري من نابلس، وكان يكفيني وزيادة، لكن ولظرف لا أعرفه، تأخرت حوالتي من والدي لمدة شهرين متتاليين، ولأن القرية صغيرة، ولا مجال لأن يعمل فيها طالب بدوام جزئي، تقشفت والتزمت بالحدود الدنيا من الانفاق، وبقيت اتناول الخبز والسردين، في تلك الفترة حتى عادت الحوالة لتصل مجددا.
لم تمارس أي نشاط سياسي طيلة فترة غيابك في أميركا؟
لا، فقط حضرت مؤتمر الطلبة العرب، والذي كان يعقد كل سنة في ولاية، وحضرت هذا المؤتمر مرتين، وكان الأمين العام للمؤتمر اسامة الباز، كما كان نبيل شعث من قياداته. طبعا لم ينقطع اهتمامي بالسياسة، فقد كنت متشبثا بأي خبر حول البلاد، خصوصا أن مطلع ستينيات القرن الماضي، كان يشهد حالة من الغليان.
وبقيت اتابع أي خبر يأتينا عبر أي وسيلة إعلام عن المنطقة، وانخرطت أيضا في متابعة الأحداث والأخبار في الولايات المتحدة، وتابعت مثلا أولا بأول أزمة الصواريخ الكوبية، أيام الرئيس الأميركي جون كيندي.
وهنا سأقول لك قصة حدثت، وكانت من باب المصادفة، فقد كان لي أصدقاء طلبة من خلية العمل الطلابي داخل الحزب الديمقراطي، وكان أحدهم ناشطا بشكل مُلفت، فدعاني لاستقبال الرئيس كيندي في مطار دالاس، فوافقت وذهبت معهم، وبعد ساعة من عودتنا إلى (دنتون) سمعنا عن خبر اغتيال كيندي.
وماذا عن الدراسة في أميركا؟
درست الإدارة العامة، لكن أهم ما يميز الخطط الدراسية للجامعات الأميركية أنها تخصص للطلبة مساقات محددة وإلزامية في التاريخ الأميركي، وفي شكل ومضمون عمل الحكومات، وهما مساران درستهما باستمتاع، فقد دفعني الفضول المعرفي عن أميركا وكيفية صناعة القرار فيها وآليات عمل الحياة السياسية والحكومات، لأن أهتم بهذين المساقين.
في أحد المساقات درسنا فصلا كاملا عن المحكمة الأميركية العليا، وهي التي تصنع القرار الأول في أميركا، فهي صاحبة الرأي الأخير في تفسير الدستور والتشريعات.
- نعم عدت، لكن إلى عمان وليس لنابلس، فبعد عودتي مباشرة أخبرني والدي بأن الدكتور خليل السالم يؤسس البنك المركزي في عمان، وأنه طلب منه توظيفي في البنك، وقبل السالم.
وفعلا ذهبت للعمل، وكان لي الشرف أن أكون بمعية هذا الرجل المعلم في مهمة تأسيس البنك المركزي، وهو صرح وطني مهم، بالإضافة لزملاء لي أذكر منهم محمد سعيد النابلسي وصفوان طوقان وزياد فريز ومروان عوض ومحمد صالح الحوراني وميشيل مارتو وأمية طوقان وباسل جردانة وعبد القادر دويك، وبسام الساكت وجواد العناني ومهدي الفرحان.
عملت في البنك المركزي سبع سنوات ونصف السنة، وكانت مكاتب البنك حينها تقع في عمارة عاكف الفايز في شارع الشابسوغ وسط البلد.
كانت لي فرصة مهمة لتعلم البيروقراطية الحكومية، على أصولها وتقاليدها، فقد ساعدنا في تأسيس البنك المركزي بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني)، وبعث لنا مصرفيا مصريا اسمه مصطفى السقاف، كما جاء خبراء من بنك انجلترا وهم من وضعوا الأسس الإدارية والمصرفية، لأننا كنا من ضمن منطقة الاسترليني.
طبعا في بداية عمل البنك لم يكن هناك "قاصة" أو خزنة لحفظ النقود، فقد كنا نحفظها في البنك العثماني، الذي كان يقع مقابل البنك العربي وسط البلد.
وبقينا على هذا الحال، حتى العام 1969، حتى تم الانتهاء من بناء موقع البنك المركزي الحالي، وتم تصميم خزنة خاصة محصنة لحفظ النقود، وأذكر جيدا كيف نقلت أنا النقود من البنك العثماني إلى خزنة البنك المركزي بمجنزرة عسكرية في ذلك الوقت.
- لا؛ لم يكن الأمر في خاطري، خصوصا أن الأجواء بقيت ملبدة بالغيوم والمواقف، وكان الاستقطاب السياسي على أشده، وأستطيع القول بأني ركزت جيدا في عملي، فالمسؤولية كانت كبيرة وهي تأسيس البنك المركزي مع نخبة من الاقتصاديين الكبار الذين تتلمذت على أياديهم.
وأذكر كيف خيرني الدكتور خليل السالم أول محافظ للبنك المركزي في السفر في بعثة دراسية إلى الخارج، وعلى حساب البنك، لكني رفضتها، وطلبت منه إن كان جادا في العرض أن يبعثني للتدريب في البنوك الأوروبية، فوافق، وقد كان حجم الخبرة والفائدة التي كونتها؛ باعتقادي، أهم من الدراسة في الخارج والانقطاع فترة طويلة عن المملكة.
وهل تأخرت في زواجك؟
- لم أتأخر كثيرا بالزواج، ولم أبكر كثيرا ايضا، لكن لطبيعة الظروف التي مررت بها، فقد تأخرت بفكرة الارتباط والاستقرار.
بدأت العمل العام 1965، وكانت الحياة بالنسبة لي محدودة، وكنت أذهب كل نهاية اسبوع إلى نابلس، فقد سكنت بمنطقة الدوار الأول في عمارة التأمين، وكان أبعد ما في عمان في ذلك الوقت الدوار الثالث بجبل عمان. كنا كشباب نخرج للسهر في أماكن محدودة جدا، مثل النادي الأرثوذكسي، أو مطاعم محدودة وسط البلد. من هناك بدأت تتشكل رغبتي في الزواج، وصرت أفكر بالأمر بجدية، لأن وضعي كان غير مستقر، كما أن النظرة الاجتماعية للشاب الذي تطول فترة عزوبيته لم تكن إيجابية.
تعرفت على زوجتي سمر عن طريق صديق قريب لي وزوجته، وكان صديقا لأهل زوجتي، وعن طريق زوجة صديقي هذا تعرفت على سمر، التي كانت تدرس في كلية التمريض التابعة للخدمات الطبية الملكية، وكان والدها طبيبا في الخدمات الطبية، وهو الدكتور سعد البيطار، وقد كان صديقا للدكتور عبد السلام المجالي.
وعند الخطبة العام 1966 جاءت جاهتي من نابلس، وكانت تضم عمي الحاج معزوز وعمي حكمت ووالدي وعمي ظافر، الذي استشهد العام 1986، وهو رئيس بلدية نابلس، توجهنا إلى معسكر الملك طلال في المحطة، حيث يسكن أهل زوجتي، إذ لم يكن من عاداتنا في ذلك الزمن أن تتوجه أعداد غفيرة إلى منزل أهل العروس، فاقتصرت جاهتي على هؤلاء، وكان في استقبالهم مع والد زوجتي حابس باشا وعبد الوهاب
وعبد السلام المجالي ومتري الشرايحة وغيرهم، عدا عن أقرباء والد خطيبتي.
كنا نخطط أنا وخطيبتي للزواج في وقت قريب، وبدأنا التحضير فعلا، لكن وقعت حرب العام 1967، وكان لها أثر مهم في إطالة مدة الخطوبة وتأخر الزواج.
• وهل عدت خلال الحرب إلى نابلس؟
- أذكر بأني أنهيت عملي يوم الخامس من حزيران العام 1967، وكنا موظفين نغادر البنك سوية، ونحن في الطريق سمعنا عن بداية الحرب بالطائرات. كنت وقتها أمشي مع صفوان طوقان، فقلت له: الحمد لله أن وقعت الحرب لنخلص من اسرائيل. كنت أسكن في بيتي على الدوار الأول، مع ابن عمي حكمت، واسمه سمير، وكنا نتندر بذلك الحدث وكأننا سكارى.
في يوم الخميس، التاسع من حزيران (يونيو)، وقد كنت في زيارة لمنزل أهل خطيبتي في معسكر الملك طلال، استمعنا لخطاب عبد الناصر، الذي أعلن فيه استقالته، وهنا كأنني صحيت من غيبوبة، وبدأت أبكي كالأطفال، وبصورة محرجة أمام أنسبائي، فقد انهارت أمامي كشاب قومي متحمس كل الآمال والطموحات، وحتى الأحلام التي بنيتها على الحرب.
بعدها بدأت أشعر فجأة بأني فقدت أهلي وجزءا من وطني، وربما شعرت أيضا بأني صرت مقطوعا بدون سند عائلي ومالي، فقد كانت استثمارات العائلة تتركز في نابلس، ولم يكن لي سوى بعض أبناء العمومة في عمان والخليج. لكن، لم أكن خائفا، وأنا في هذا الوضع الصعب، واستمررت في عملي وبذات الأسلوب المعتاد.
ثم بدأت التخطيط لما بعد، وكيف سأعتمد على نفسي، خصوصا وأنني خاطب منذ عدة شهور، وكانت العادات أن لا تطول فترة الخطوبة، ولم أكن أملك أي فرصة كافية للتعامل مع الأحداث الطارئة، خصوصا أن والدي رحمه الله أصيب بالمرض في تلك الفترة، وأصبح قعيد الفراش.
أذكر بأني بعد الاحتلال بأيام قليلة عبرت النهر متسللا لزيارة أهلي، ورأيت لأول مرة في حياتي الجنود الإسرائيليين داخل الضفة، وهو أمر يترك في النفس غصة، ما زالت مرارتها لليوم في قلبي.
مع بداية مرض والدي، أوقفت التحضيرات للزواج، وأخذت إجازة من البنك وذهبت لنابلس، وكانت نيتي تتجه للبقاء مع العائلة خلال ظروف مرض والدي، لكن لم يطل بقائي هناك، عدت بعد فترة لعمان، بعد ان استقرت الأمور العائلية قليلا، وفكرت في اتمام الزواج ضمن أجواء هادئة جدا.
اتفقنا، نحن الخاطبين الثلاثة للشقيقات الثلاث، وكنا أنا وسطام حابس المجالي وزياد مراد وهو الضابط في سلاح الهندسة الملكي، فقررنا أن لا نقيم أي احتفال، بسبب تلك الظروف الحزينة، التي تعيشها المملكة، فقررنا أن نذهب ثلاثتنا صباحا، ليصطحب كل زوجته، ويغادر في شهر عسل، فذهبنا أنا وزياد إلى بيروت، فيما ذهب سطام إلى لندن.
طبعا، كان شهر عسل بالمعنى المجازي، فلم اتمكن من الغياب لأكثر من أربعة أيام، بسبب الظروف الاقتصادية التي كنت أعيشها، فقد كنت متقشفا جدا في تلك الفترة.
قبل ذلك كنت قد استأجرت بيتا في جبل عمان بالقرب من مستشفى فرح الحالي، والمنزل تعود ملكيته إلى الحاج عادل حبيبة، وكان البيت مهملا وغير مسكون، وهو في حالة غاية في السوء.
كان في البيت عفش قديم، ولما أقمنا فيه أنا وزوجتي كانت الرطوبة تقتلنا في ليالي الشتاء، فلم نكن نملك ثمن التدفئة، وعشنا في المنزل في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها صعبة، لكن تحملناها أنا وأم نشأت.
أذكر بأن راتبي في تلك الأيام لم يتجاوز الـ60 دينارا، كما عملت زوجتي في مكتبة في فندق الأردن، براتب 22 دينارا، لمساندتي في المسؤولية، لكنها لم تستطع العمل لأكثر من 4 أشهر بسبب صعوبة التوفيق بين مسؤوليات المنزل والعمل.
كانت فترة صعبة وقاسية، لكن كانت فيها متعة، فقد أثثنا منزلنا قطعة قطعة، أذكر بأن أول قطعة أثاث اشتريناها كانت المدفأة، وكانت "صوبة كولمان" مستعملة، وبعد فترة قررنا تفصيل غرفة النوم، وكانت تحتاج منا "تحويش" مبلغ 100 دينار، وبعدها اشترينا طقم كنب مستعملا، لكنه بحالة جيدة، فأثثنا المنزل على مدى أشهر طوال، معتمدين على دخلنا وعلى أنفسنا.
- بصراحة أيضا؛ كنت أحاول الابتعاد عن الشأن السياسي خلال عملي في البنك المركزي، وهي رغبة خلفتها تداعيات حرب العام 1967، والإحباط الذي تسبب به احتلال الضفة الغربية.
لم أكن في وقتها راغبا في التعاطي مع الشأن السياسي، خصوصا أن احتلال الضفة سبب لنا حالة من فقدان الثقة بالأنظمة الشمولية، وفقدان الثقة بالوعود التي ظلت تنبعث دون حسيب أو رقيب.
كان لي في أيلول (1970) وجهة نظر، وما زلت متمسكا بها، فأيلول لم تكن حربا أهلية، فالحرب الأهلية هي بين مكونين في ذات البلد، ويجر لها المدنيون عنوة، ويكونون مهددين بأرواحهم وأهلهم وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم.
أيلول لم تكن كذلك، بل كانت مناوشات بين أحزاب سياسية تحمل السلاح، وتريد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبين الجيش والأمن الأردني، الذي رفض مظاهر حمل السلاح في الشوارع، واستمرار مظاهر الانفلات الأمني. فمرجعية الأمن يجب أن تكون واحدة وهي السلطة. أنا شخصيا كنت وما أزال مع النظام العام، الذي يحمي الجميع من الخطر، ويحصن المدنيين من أي شعور بعدم الاستقرار وغياب الأمن.
في تلك الأيام، كانت فوضى السلاح تشي بالخطر، وأذكر بأني نمت على مكتبي في البنك المركزي ليالي كثيرة، بسبب تلك الفوضى، فقد كان مفتاح خزنة البنك المركزي معي وكانت الاشتباكات عندما تجري عند باب البنك، في بعض الأيام بالسلاح والذخيرة الحية، كنت أفضل حينها أن أبقى في البنك، على الخروج، لأنني لست المهدد بالخطر، بل أموال الخزينة العامة، خصوصا إذا ما قدر لأحد وانتبه بأنني أحمل المفتاح لحظة خروجي من البنك.
كانت الفوضى تجعلك لا تطيق هذه المظاهر العسكرية، كنا نمشي تحت الرصاص، وكنا مهددين بالموت، لأن هناك من لا يستجيب لفكرة الالتزام بعدم حمل السلاح داخل المدن.
كلنا مع الفدائيين، وحتى النظام الأردني، فقد قدم وقتها دعما لهم، في تنفيذ عمليات داخل الضفة، وقد كانت الحدود بين الضفتين نشطة بعمليات للفدائيين، وبدعم الجيش العربي والأمن الأردني، لأن الفدائيين هم أمل لنا في إذاقة الإسرائيليين مر العذاب، وبرأيي وما أزال متمسكا به، بأن الفدائيين لهم أعمال بطولية على الحدود الأردنية الفلسطينية، لكنهم اخطأوا عندما سمحوا بأحداث أيلول.
لا أريد لأحد أن يفهمني خطأ، لأن وجهة نظري ما تزال واحدة وهي: أن عدونا واحد، وهو اسرائيل وليس أحدا آخر، لذلك لم أكن مع أيلول، ولا إرهاصاتها من قبل، ولا تداعياتها من بعد.
لا نريد أن نحفر في وجعنا، لكن أيلول شكلت محطة سلبية في تاريخ العلاقة التاريخية بين الضفتين والشعبين والتوأمين، لكني ما أزال مصرا على أنها ليست حربا أهلية، بل حرب بين سلطة تريد حفظ النظام العام، وبين أحزاب سياسية لها هوية مقاومة الاحتلال، وتحمل سلاحا داخل مجتمع مدني.
تنويه
وجاء في الحلقة "بأن شاهر اليوسف (شاهر أبو شاحوت) أعلم والد طاهر المصري بأن القيادة في عمان، على وشك اعتقاله، وأنه ينوي الاختباء في نابلس، إلى حين ترتيب خروجه من الأردن، وشارك والدي في ترتيب ذلك، وفعلا لجأ شاهر إلى سورية، بعد مساعدة والدي له، وهو أمر خطير ذلك الوقت، فقد كان التعامل مع مسألة بحجم تهريب أي رجل مطلوب للسلطات والحكومة ينتهي بعواقب وخيمة".
والتزاما بالدقة التاريخية في رواية الحدث، اتصل المصري أمس مع "الغد" وطلب حذف الفقرة، فقد اختلط الأمر من بين أسماء تشكيلات الضباط الأحرار الذين هربهم والده إلى سورية عبر نابلس باستخدام سيارات نقل الخضار.
وأكد المصري بأن الأسماء تداخلت على ذاكرته، وأنه ليس متأكدا بدقة من اسم الشخصية التي هربها والده، ولا يريد أن يحدد أسماء الشخصيات التي ساعد والده بتهريبها من نابلس، لذا اقتضى التنويه.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved