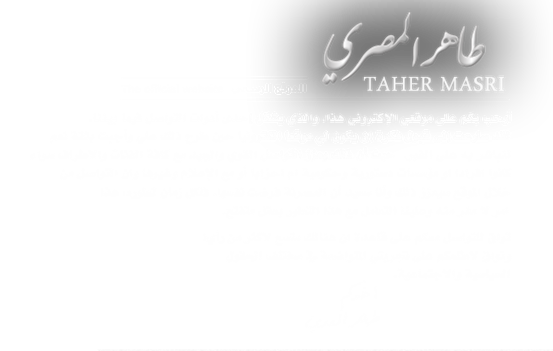

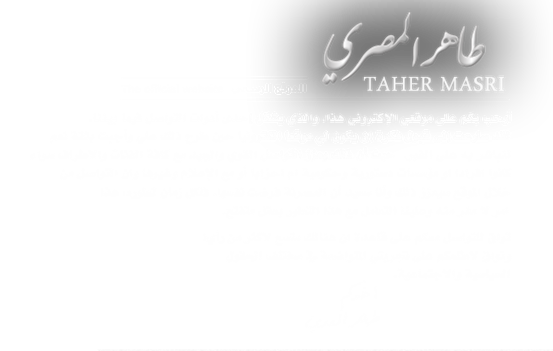

سياسي يتذكر الحلقة الثانية
21 نيسان 2014
المصري: وحدة الضفتين دعمت جبهة الأمة
محمد خير الرواشدة
عمان-بعد أن عرض رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إيجازا حول نشأته وملاحظات عايشها طفلا خلال أحداث النكبة وتدفق اللاجئين الفلسطينيين العام 1948، يواصل رواية مذكراته في أعوام عُمره الأولى.
ويستكمل المصري، الذي شغل سابقا منصبي رئيسي مجلسي النواب والأعيان، سرد ذكرياته بنابلس التي وُلد ونشأ ودرس فيها قبل أن يسافر للولايات المتحدة الأميركية طالبا جامعيا.
وفي الحلقة الثانية من سلسلة "سياسي يتذكر"، التي تنشرها "الغد" على مدى الأيام المقبلة، يكشف المصري عن اهتمامه الأول في العمل السياسي، ومشاركته في المسيرات والاحتجاجات الشعبية داخل نابلس ضد دخول الأردن في حلف بغداد.
كما يكشف عن تأثر جيله بمعلميهم، وكيف شكلت المدارس في ذلك الوقت حلقة تربوية وتعليمية صقلت شخصية الطلبة وانعكست على مدى جديتهم.
لكن المصري يستذكر بألم مظاهر القمع التي تعرضت لها كل مناطق المملكة في الضفتين نتيجة خروج المسيرات الشعبية الاحتجاجية ضد مشاركة الأردن في حلف بغداد.
ويروي باستغراب تعامل السلطات العسكرية مع عائلته، وتحول العلاقة بين أسرته والمؤسسات الرسمية إلى حالة من القطيعة والقمع، خصوصا بعد أن فُرض على والده وأعمامه الإقامة الجبرية في منازلهم، إثر تلفيق تهمة له بـ"شتم الملك" نتيجة محاولته حماية مواطن لجأ إليه.
ولا يُخفي المصري بأن علاقات والده (نشأت)، رحمه الله، كانت متشعبة بين مؤسسات القرار والحكام العسكريين وبين تشكيلات الضباط الأحرار، كما يكشف عن طرق تهريب والده لمعارضين سياسيين مطلوبين أمنيا إلى سورية.
ويتحدث المصري عن تفاصيل آخر زيارة قام بها جلالة الملك المؤسس الشهيد عبدالله الأول لنابلس قبل رحلته الأخيرة إلى القدس واستشهاده هناك.
ويستذكر في هذا السياق أدق تفاصيل تلك الزيارة، حيث كان يقيم الملك الشهيد في منزل عمه الحاج معزوز المصري كلما أراد زيارة نابلس، واصفا مشاعر الحزن التي عاشتها عائلته ونابلس بعد استشهاد الراحل عبدالله الأول، خصوصا بعد أن حاول عمه مع الشهيد الملك المؤسس بأن يُصلي في نابلس ويتناول الغداء معهم، لكنه رفض وأصر على الذهاب للقدس ليستشهد على بوابة الأقصى.
كما يروي المصري كيف كان يستمع ووالده لإذاعة القدس التي كانت تتحضر يومها لنقل صلاة الجمعة من المسجد الأقصى، وكيف استمعوا للحظة إطلاق النار باتجاه الملك المؤسس أثناء تواجدهم برام الله قبل أن ينقطع بث الإذاعة.
ومن أين بدأت مشاركتك في العمل السياسي؛ هل كنت حزبيا وأنت في المدرسة مثلا؟
كنت أنتمي أصلا لعائلة سياسية، اشتبكت مع العمل السياسي مبكرا، وذلك بسبب المشاركة في الانتخابات، ونشأت على هذا الأساس، وكنت استمع لكل الحوارات التي كانت تدور في بيت العائلة، أو حتى في المواقع التي كنت أزورها مع والدي، كنشاط انتخابي في تلك المواسم.
أنا حضرت فرز الانتخابات في متصرفية نابلس مع والدي، وكان هذا في مطلع خمسينيات القرن الماضي.
لكن في المدرسة، كانت هناك أيضا تعبئة سياسية يمارسها المعلمون، وأحيانا بدون قصد، ومرات كثيرة بقصد، وهو ما شكل حجر زاوية في فهمنا لما يجري من حولنا.
لكن، لم نتأثر بأفكار المعلمين حزبيا، وهم لم يطلبوا منا صراحة أن ننتمي لكوادر الحزب، الذي يمثلونه، لكن ونتيجة لكل هذه التعبئة المدرسية، تجاه ما يجري في المنطقة العربية عموما، وفلسطين خصوصا، كان سهلا عليّ أن أخرج مشاركا في أي مظاهرة، تندد بموقف ما، أو تستنكر فعلا ما، أو تنحاز لقضية ما.
ما أذكره جيدا، بأن أول مظاهرة احتجاجية شاركت فيها في نابلس، كانت ضد انضمام الأردن لحلف بغداد سنة 1955.
وطبعا، لمن يتذكر تلك الحقبة، فقد كان هناك رأي عام ضد حلف بغداد ودخول المملكة فيه، وكانت تغييرات الحكومة في تلك الفترة سريعة. أذكر جيدا بأن عمر إحدى حكومات الشهيد هزاع المجالي كان 6 أيام، وحكومة الدكتور حسين فخري الخالدي رحمه الله استمرت 3 أيام فقط.
وللتاريخ أيضا، فقد كانت مؤتمرات نابلس التي تنعقد بحضور زعامات ووجهاء وشيوخ وممثلي المدن والقرى من الضفتين الشرقية والغربية، كانت توجه رسائل واضحة بهذا الخصوص، وقد كان لتلك المؤتمرات علاقة أيضا بتحديد عمر الحكومات، من خلال قدرتها على تعبئة الشارع، وتنفيذ المظاهرات الشعبية ضد الحكومات، وإغلاق الأفق السياسي أمامها. فقد وجهت مؤتمرات نابلس إنذارات للحكومات من مغبة الانضمام لحلف بغداد، كما كان لها دور في المشاركة في صنع السياسات واتخاذ المواقف، ولهذا تداعيات على أسرتي ووالدي وأعمامي سأرويها بعد قليل.
لكن عن مشاركتي السياسية في ذلك العقد الزاخر بالأحداث السياسية، فلم أكن حزبيا، ولم أحسب على أي تيار حزبي، لكني كنت أشارك في المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، تأثرا عاطفيا بالموقف العام، من القضايا داخل فلسطين والأردن، وقضايا العالم العربي
وقد خرجنا يوما في مظاهرة احتجاجية، باتجاه القنصلية البريطانية في نابلس، وكان اسم القنصل وقتها، الميجور (هاكتبن)، وله منزل أيضا في منطقة رفيديا غرب نابلس. أردنا حرق منزله والقنصلية، لكننا لم نتمكن بفعل الحراسة، التي فرقت المظاهرة.
وكيف تصف مظاهر القمع الحكومي ذلك الوقت؟
كان قمعا مرعبا، وشديدا لا يرحم. هدف القمع هو تفريق أي تجمع سياسي في كل مناطق المملكة.
وقد نلنا في نابلس حصة وافية من هذا القمع، الموجه ضد كل الحراك السياسي وقتها، لكن ميزة هذا القمع أنه توزع بالتساوي بين كل مناطق المملكة، دون أن يميز بين هذه المنطقة، غرب النهر، أو تلك المنطقة، شرقيه.
ولذلك، فإن التساوي بالقمع، شكل حالة عامة بين الضفتين، ودفعت الجميع، مواطنين وقوى سياسية، إلى رفضه، والشكوى من تداعياته، والعمل ضده، وهو ما جعل إقالة الحكومات تتم سريعا، وبالنتيجة فهذا ما أدى إلى دمقرطة الحياة العامة؛ إذا جاز التعبير، وذلك من خلال إجبار السلطات على ذلك، ومن خلال العمل المنظم ضد كل ما هو غير ديمقراطي، ويعارض توجهات أغلبية الرأي العام.
كانت حياة سياسية حقيقية، وليست وهمية، وهو ما يجعلك تندفع طوعا للمشاركة في أي عمل سياسي، سواء ضد الحكومات أو مع الحكومات، وهو ما حصن جيلنا بأسره، بوعي في الاتجاهات والأفكار والقيم، بدءا من الجو القومي العام عربيا، وصولا لمعنى العمل الوطني في حلقته القطرية أو المناطقية، لكن من دون أن يكون هناك أي فوارق تشكل "حزازات" في نفوس الناس، أو أمراضا اجتماعية، مثل التعصب والإقليمية والمناطقية والجهوية، وتحديدا بين الضفتين، اللتين شكلتا حلقة اجتماعية مربوطة بأواصر وثيقة وأصيلة، تبدأ بالشعور بالمصير المشترك، وتمر عبر علاقات انسانية بمختلف مستوياتها، وبيئات متشابهة، وظروف متشابهة أيضا بالخير والشر.
لذلك، إن التساوي بقمع المظاهرات والمسيرات المناهضة لانضمام الأردن إلى حلف بغداد، كان مظهرا يبعث على الطمأنينة، بأن سلوك الحكومات المركزية، هو موجه ضد فعل وليس ضد جهة، وهذا صحيح أنه معنى سلبي للعدالة والمساواة، لكن هكذا كنا، وهكذا يجب أن نظل، بمعنى أن نبقي على قيم العدالة الاجتماعية؛ بمعناها الإيجابي، وهي التي تؤسس لمشاعر سامية من التسامح والترابط.
- نعم؛ قلت إن عائلتنا كانت ناشطة في العمل السياسي، وكان والدي صديقا مقربا من كبار موظفي الدولة، فقد كان صديق والدي الشخصي، المشير حابس المجالي، رحمه الله، الذي كان حاكما عسكريا عاما. كما كانت علاقات والدي تمتد حتى مع شخصيات من تشكيلات الضباط الأحرار، مثل محمود المعايطة وشاهر أبو شاحوت رحمهما الله.
حتى أن ابو شاحوت، وكنا نعرفه باسم شاهر اليوسف، أعلم والدي بأن القيادة في عمان، على وشك اعتقاله، وأنه ينوي الاختباء في نابلس، إلى حين ترتيب خروجه من الأردن، وشارك والدي في ترتيب ذلك، وفعلا لجأ شاهر اليوسف إلى سورية، بعد مساعدة والدي له، وهو أمر خطير ذلك الوقت، فقد كان التعامل مع مسألة بحجم تهريب أي رجل مطلوب للسلطات والحكومة ينتهي بعواقب وخيمة.
وطريقة تهريبه تمت بقيام والدي بتحضير شحنة من الخضار، وتصديرها إلى سورية، وجهز بين صناديق الخضار، المصفوفة على ظهر الشاحنة؛ مكانا يجلس فيه الرجل، حتى عبرت الشاحنة إلى سورية، دون أن ينكشف الأمر.
الحاكم العسكري العام كان حابس باشا (المجالي) رحمه الله، وجاء بهجت طبارة كحاكم عسكري لنابلس، وقد جاء بمهمة تأديب أهل نابلس، على معارضتهم للسياسات الحكومية، ودعمها للخط الناصري. طبعا في هذه اللحظة تغير شكل التعامل مع المواطن، فقد كان طبارة فظا قاسيا في تعامله، وفي حكمه العسكري، على نابلس وأهلها.
صحيح أنه كان ينفذ توجهات الحكومات، التي كانت تنزع للقمع والتخويف ضد المظاهرات والمشاركين فيها، لكنه زاد على ذلك غلظة وجبروتا، ما يزالان في الذاكرة حتى يومنا هذا. في تلك الأيام من العام 1957 فرضت الإقامة الجبرية على والدي وعلى عمي حكمت في منزليهما.
أذكر أن والدي حاول في تلك الفترة حماية مواطن، احتجزه الشرطي المتواجد في بيتنا، والذي يقوم بتنفيذ الإقامة الجبرية بحق والدي، فكتب فيه أحد "المخبرين الصادقين"، بأنه شتم الملك، وفور وصول التقرير، جاءت قوة عسكرية، وأودعت والدي السجن، وبحكم قضائي عسكري مدته ثلاثة أشهر. كان عمري 16 عاما، وأذكر القصة وكأنها تحدث أمامي الآن.
وأمضى والدي أيام الحكم، وكنت أوصل له الفطور صباح كل يوم، وأنا متجه إلى مدرستي، حتى حفظ الضباط شكلي. كنت أقود سيارة والدي، حتى أستطيع لملمة وجبة الإفطار من السوق، وأذهب لمدرستي، ثم أعود للمنزل لأمارس الواجبات المطلوبة، وأحاول أن أسد بعض المسؤوليات، التي كان يقوم بها الوالد رحمه الله.
ولأن قيادتي للسيارة ممنوعة، بسبب عدم بلوغي السن القانونية بعامين، لتحصيل رخصة القيادة، فقد ذهبت إلى الضابط الرئيسي لسير نابلس، وكان شركسيا، اسمه عزير أيوب، وأخبرته بالمشكلة، وبأني مضطر لنيل رخصة القيادة، في عمر الـ16 عاما، وتفهم الأمر، وحصلت على رخصة القيادة العام 1958، بعمر أقل من العمر القانوني، لكن لظرف استثنائي.
- أمضاها كاملة، لكن بأسلوب غريب، ما زلت عاجزا عن فهمه. في أحد الأيام، وبعد إحضار الفطور، كعادتي اليومية، لوالدي في السجن، دخلت، ولم أجد والدي، ولا حتى المحبوسين معه. وبدأنا رحلة السؤال عن المكان، الذي رحل إليه المساجين، ولم يكن ليجيبنا أحد عن هذا السؤال البسيط. أذكر بأنه مر وقت حتى عرفنا بأنهم رُحّلوا إلى سجن الجفر، ولسبب غير معلوم، وبقوا مسجونين في الجفر، حتى إعلان الاتحاد الهاشمي، ثم أعادوهم لنابلس، وأطلقوا سراحهم بعفو ملكي.
بعد يومين من إطلاق سراحهم، كنت أنا ووالدي في مكتبه، في العمل، جاءت الشرطة، وقالت لوالدي، بأنه مطلوب، وأن عليه أن يكمل مدة محكوميته في السجن، وأن العفو الملكي قد لا يشمله، طلب مني والدي الذهاب إلى المنزل وتحضير حقيبة، حتى يستكمل مدة محكوميته، ذهبت مصدوما إلى البيت، وأخبرت أمي التي بدأت بالبكاء، وبقيت متمالكا نفسي أمامها، حتى دخلت إلى الحمام، ومن قهري انهمر الدمع من عيني بحرقة.
للأسف الشديد، لم يُقدم أحد من أصدقاء والدي الخُلص، من المسؤولين، يد المساعدة له، وهم يعرفون جيدا أن كل الأمر تلفيق.
- بعد إقالة حكومة سليمان النابلسي مطلع نيسان (ابريل) العام 1957، تركنا الانتخابات، ولم يترشح أحد من العائلة، وكان ثمة شعور عام بالإحباط، ليس لدى عائلتنا فقط، بل لدى الجميع، حتى أن الانتخابات التي أجريت بعد إقالة حكومة النابلسي، وحل البرلمان، جاءت بأسماء جديدة، لم يعهدها أهل نابلس من قبل، وكان هناك انطباع عام، بأنهم غير ممثلين لأهالي المنطقة.
- قد لا تكون الإجابة عندي، لكن الظلم والقمع طالا الجميع. فكنا فعلا نعيش حالة الطوارئ العسكرية، وتداعياتها الصعبة، على الحياة العامة.
لكن قد أتفق معك بالاستغراب حيال الأمر، فقد كانت العلاقة بين الملك الراحل والعائلة حميمة جدا، وقد كان يزور نابلس باستمرار، وكان يحظى باستقبال دافئ وعفوي وصادق.
وأذكر، وقد كنت طفلا صغيرا، بأن أهل البلد، كانوا يحضرون لإهداء الملك عبد الله الأول، منزلا خاصا ليقيم فيه أثناء زياراته لنابلس. وفعلا، فقد كان منزلا جميلا، وفي موقع مميز أقيم في قلب البلدة القديمة، لكن وللأسف لم يسكنه، لأنه استشهد قبل أن ينجز المنزل، ليصبح بعد ذلك المنزل مقرا لبلدية نابلس.
- الوحدة تمت بكل حرية ورغبة، ولم يكن هناك من يعارض في تلك المرحلة أي مشروع وحدوي يقوي جبهة الأمة، وخصوصا بعد أحداث النكبة العام 1948.
معروف أن الوحدة بين الضفتين جاءت في أعقاب مغادرة الانتداب البريطاني فلسطين، والذي رحل في 15-5-1948، دون أن يترك لأهل الضفة الغربية دولة أو مؤسسات أو جسم دولة، مكون من مؤسسات قانونية أو منتخبة، لذلك بقيت الضفة كيانا غير واضح. لذلك كان له ارتباطاته مع الضفة الشرقية، فالمملكة الأردنية الهاشمية استقلت العام 1946، وأصبحت دولة ذات سيادة، وفيها بناء مؤسسي، لم يكن متوفرا في حالة الضفة الغربية.
أذكر جيدا، بأن نمر السيارات، مثلا، كانت تحمل حرف (الباء)، في إشارة إلى محافظة البلقاء، وهذا مثال على الارتباط مع الأردن قبل الوحدة، وقد كان ارتباطا لغايات تنظيمية بالأساس.
بعد ذلك، انعقدت مؤتمرات متعددة، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وأعلن زعماء تلك المؤتمرات، طلبهم للوحدة مع الضفة الشرقية، وسارت الأمور من دون معارضة أو اعتراضات.
وهنا يجب التأكيد على جزئية غاية في الأهمية، فالجيش العربي كان قد دخل فلسطين وحارب فيها، وحمى أجزاء عديدة منها، وعلى رأسها القدس الشرقية، وكلنا يتذكر بأن أول شهيد سقط على أرض فلسطين كان أردنيا. وهو الشهيد كايد مفلح العبيدات.
لذلك، فالوحدة مع الضفة الشرقية تمت بشكل سلس ومريح، وعن سابق رغبة في الأمر. وعندما جرت الانتخابات النيابية في الضفة الغربية لبرلمان الوحدة، كان التنافس شديدا وصحيا وسياسيا، وشاركت فيه زعامات الضفة الغربية.
وكان الملك رحمه الله، إذا ما أراد المبيت في نابلس، ينزل في بيت عمي الحاج معزوز المصري. كان بيته واسعا، يليق بمقام الملك.
كان منزل عمي في المساء، وعندما يكون الملك حاضرا، يعج بالضيوف، الذين يريدون السلام والجلوس مع الملك عبد الله الأول. كنا كأطفال نتطفل على ديوان منزل عمي معزوز، حتى يتسنى لنا رؤية الملك. أذكر أن أصغر عماتي كانت طفلة تلعب معنا، واسمها هالة. كانت هي الاستثناء الوحيد كأنثى التي يُسمح لها من دون الفتيات الصغار بالجلوس معنا بمعية الملك.
أذكر أننا شاهدنا الشهيد الملك عبدالله الأول، آخر مرة، صباح يوم استشهاده، إذ كان موجودا في منزل عمي الحاج معزوز.
وكان الملك رحمه الله مصرا على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما يلح عليه عمي للبقاء في نابلس. وأذكر تماما، وكأن الصورة أمامي الآن، عمي يقول للملك: أكرمنا مرة وصلي الجمعة في نابلس، فأنت لم تصل الجمعة، ولا مرة، في نابلس، وبعد الغداء تستطيع أن تغادر بسرعة.
لكن الملك اعتذر عن قبول دعوة عمي، وأصر على الذهاب إلى القدس، وركب سيارته متوجها إلى هناك.
في ذلك الحين، كان من عادات أهل نابلس، ومن بروتوكولات التعامل مع الملك، أن يخرج كبار المسؤولين والشخصيات في البلد إلى حدود المتصرفية، ليوصلوا الملك إلى هناك، ويكمل طريقه، كانت حدود المتصرفية قرية اسمها اللبن، بين نابلس ورام الله، وكان هناك مخفر للشرطة، ذهبنا جميعا، وتم وداع الملك، ثم عاد أهل نابلس لبيوتهم، وأكمل والدي ومعه بعض الأصدقاء؛ وكنت معه، الطريق إلى رام الله، لتناول طعام الغداء في فندق حرب.
وصلنا الفندق، وكان لنا قريب اسمه عباس داخل المطعم، يشرف على تحضير الغداء، وعندما سمع إطلاق نار يأتي عبر أثير إذاعة القدس، التي كانت تتحضر لنقل خطبة صلاة الجمعة، في تلك اللحظة، وبعد سماع إطلاق أعيرة نارية عبر الإذاعة، استمعنا لعدة ثوان أصوات صياح، وأغلقت المحطة مباشرة، فجاء عباس لوالدي، وقال له والدي: لقد اعتدوا على الملك. وقال للجميع عودوا إلى نابلس، قبل أن يتم إغلاق الطرق. وبفارق بسيط من الزمن، أعلن عن وفاة المغفور له الشهيد الملك
عبد الله الأول، وهو حدث كان له اتصال وثيق بمشاعر حزن وألم، عشناها كعائلة، فقد كان جدي وأعمامي تربطهم علاقة دافئة وحميمة مع الملك رحمه الله.
لذلك، بقيت مستغربا من التعامل الفظ، الذي لقيه والدي وأعمامي، والقمع الذي مورس ضدهم من جانب السلطات، التي تعرف عن طبيعة علاقتنا بالشهيد الملك
عبد الله الأول. وهو ما ظل يحيرني كشاب يافع، لم أجد أي مبرر موضوعي لإخضاع والدي وأعمامي للإقامة الجبرية، أو لحبس والدي، ثم العفو عنه، ثم العودة لمطالبته بإكمال مدة محكوميته، كلها مواقف على تناقضاتها ظلت تعصف بخاطري، دون أن أجد ما يفسر كل ذلك نهاية عقد الخمسينيات.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved