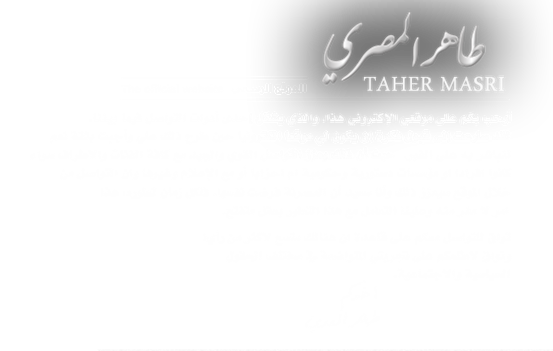

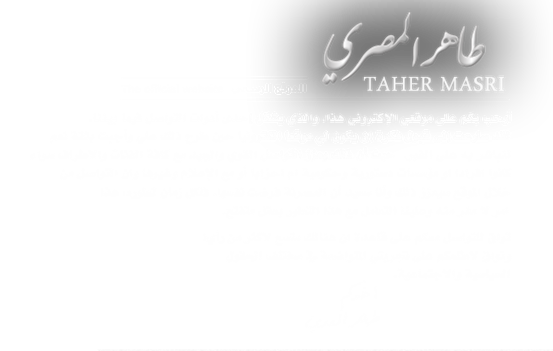

الحلقة الأولى
20 نيسان 2014
"الغد" تستضيف طاهر المصري في "سياسي يتذكر"
طاهر المصري: النكبة الفلسطينية وعائلتي السياسية أسّسا لوعيي وشخصيتي
محمد خير الرواشدة
عمان-يمكن تقليب صفحات الكثير من الكتب، التي تتناول مفاصل في تاريخ الدولة الأردنية، وهي كتب، إن صدرت على شكل مذكرات وسير ذاتية لشخصيات، فإنها أيضا تناولت التسلسل التاريخي لنشأة وتطور المملكة، نظاما ودولة.
لكن تبقى مساحات عريضة من فصول التاريخ السياسي للمملكة مسكوتا عنها، وقصة تلك الفصول، ما تزال محفورة في صدور شخصيات عايشت تلك الفترات، وهي شخصيات تُحكم إطباق الشفاه، خصوصا إذا ما كان تاريخا، هم شهود فيه أو عليه؛ يتعلق بأحياء ما زالوا يتنفسون.
وحلقات "سياسي يتذكر"، التي أطلقتها "الغد" العام 2010، تسعى إلى توثيق الرواية الشفوية لتاريخ الأردن السياسي، تواصل من جديد النبش في ذلك التاريخ، من نافذة إغراء تسجيل السير الذاتية لشخصيات اختبرت مواقع المسؤولية، والتطرق لمفاصل مهمة في بناء الأردن.
استكمالا لذات المشروع، تأتي استضافة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس مجلس الأعيان السابق، والنائب والسفير والوزير طاهر المصري، لكشف النقاب عن قضايا عاصرها، ولم يُعلق عليها من قبل.
ويتناول المصري، الذي عايش بعيني الطفل، آثار نكبة فلسطين، وتابع تدفق اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وسافر طالبا وعاد موظفا، وترشح في الانتخابات التكميلية لمجلس نواب (الضفتين) العام 1973، ثم عين وزيرا في حكومة زيد الرفاعي الأولى، من العام نفسه، وبعدها عين سفيرا في مدريد وباريس ولندن.
وهي المحطات، التي أهلته ليعود وزيرا للخارجية بحكومة أحمد عبيدات، ويستمر في موقعه حتى تقديم "استقالته" من حكومة زيد الرفاعي، على خلفية قرار فك الارتباط، لينقذه ذلك الخروج، ويعيده إلى حكومة زيد بن شاكر الأولى، نائبا لرئيس الوزراء، ثم وزيرا للخارجية في حكومة مضر بدران الرابعة، ثم رئيسا للحكومة التي قررت المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام، تمهيدا ليكون رئيسا للدورة الاولى لمجلس النواب الثاني عشر العام 1993.
ليواصل بعد هذه المحطات مشواره السياسي كقريب من مراكز القرار، حتى أبعدته عنها مواقف اتخذها دون مواربة أو اختباء؛ تحديدا بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وإقرار قانون المعاهدة.
ينتمي المصري لجيل رجالات الراحل الملك الحسين، ويكشف عن سر اكتسابه الخبرة عبر ملاحظة الحسين في كل تفاصيل مشواره، وهو ما جعل المصري قريبا وحاضرا في أضيق دوائر صناعة القرار، حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي.
بعدها عايش المصري أحداث مرض الحسين وجنازته العظيمة، ودخل في عهد المملكة الجديد، مخلصا للعرش ورسالته، مستكملا حضوره الهادئ في الحياة السياسية، ليكون عرابا للجنة الأجندة الوطنية صاحبة الجدل، وعضوا في لجنة توصيات مؤتمر كلنا الأردن، قبل أن يكون رئيسا للجنة الحوار الوطني، في وقت كان يجلس فيه على سدة رئاسة مجلس الأعيان، بدوراته الثلاث.
لم يتوقف المصري عند موقف خروجه من "الأعيان"، وينشط اليوم في عمله العام، محاضرا ومشاركا في العديد من الندوات وورش العمل المحلية والعربية والإقليمية، ويناضل في مساحة بات خبيرا في تفاصيلها وهي: مشاريع الإصلاح الشامل وجدوى الإسراع في تلمس نتائجها؛ خدمة لاستقرار النظام السياسي، واستعادة للفاقد من الثقة الشعبية.
الحلقة الأولى اليوم تتناول مع المصري النشأة والبدايات الأولى.
وفيما يلي التفاصيل.
رئيس وزراء ورئيس مجلس النواب، وئيس الأعيان، الوزير والنائب والسفير، كلها ألقاب اختبرتها، حدثنا عن بدايات هذه الشخصية التي تقلدت جميع هذه المناصب، الولادة والنشأة؟
ولدت في نابلس العام 1942، كأكبر الأبناء والبنات لوالدي نشأت، رحمه الله. ما ميز السنة التي ولدت فيها بأنها كانت استمرارا لمسلسل تداعيات هجرة اليهود إلى فلسطين. فقد كشفت الأيام المتتالية عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار، التي ستعيشها نابلس وفلسطين والمنطقة. لكن ما عرفته لاحقا هو أن مطلع أربعينيات القرن الماضي كان يشي بنهاية ذات العقد، الذي تسبب بنكبة الشعب الفلسطيني، والتي ما نزال نعيش آثارها حتى يومنا هذا.
ولدت كابن أكبر، لوالدي صاحب الترتيب الثالث بين أعمامي، وكان لي 6 أشقاء، و4 شقيقات. ولتسميتي قصة، أزعجت جدي ماهر، التاجر المعروف في فلسطين.
طبعا، ولدت في منزل جدي، الذي كان يضم كافة أفراد العائلة، وقيل لي أن والدي، وبعد مولدي بعام، انتقل ليسكن في منزل آخر، وكان جريئا في خطوته هذه، وذلك بحكم التشدد بالتمسك بالتقاليد العائلية الصارمة في نابلس، والتي كان جدي يحرص على الالتزام بها، خاصة وان نابلس مدينة تميل إلى الأسلوب والنمط المحافظ ذلك الوقت، والتمسك بأصول العادات والتقاليد. وهل كان السبب وراء استقلال والدك بمنزل آخر عن العائلة، له اتصال بغضب عائلي؟
إطلاقا. كان والدي المُدلل بين أشقائه، وظل لصيقا بجدي طيلة حياته. لكن، كما قلت، والدي يحب أن يكون مختلفا، وقد كان جريئا في مواقفه.
ومن المواقف التي كانت تؤكد طبيعة وشخصية والدي، ما قيل لي فيما بعد، بأنه عندما أراد الزواج، وبعد أن بحثت عماتي له، عن عروس تناسبه، واستقر الخيار على بنت القاضي المعروف، وقتها، يوسف الصلح، المقيم في يافا، حيث كان الصلح معروفا باستقامته والتزامه الشديد. رافق والدي عماتي إلى بيت القاضي، ليرى الفتاة التي اختارتها عماتي، وطبعا، ولأنه لن يتمكن من رؤيتها بسهولة، فقد مثل دور سائق العائلة، الذي أقل عماتي، وهناك رآها خلسة، لكن من دون أن يدور بينهما أي حديث. طبعا "انكشفت" لعبة والدي، لأنه بالغ يومها بأناقته، لكن دون أن يتسبب ذلك بأي ضرر له أو لوالدتي.
قبل الإمعان في وصف بيئة نابلس، وذاكرة الطفولة المبكرة هناك؛ لماذا غضب جدك على تسميتك باسمه؟
هي قصة، قد نستغربها اليوم، لكنها حصلت في الواقع. فقد كان تفسير الناس في ذلك الزمن لتسميتي باسم جدي طاهر، معنى من "الفأل السيئ"، أي أن مولد طاهر الصغير، يعد إيذانا برحيل طاهر الكبير، وهو ضرب من الخرافة، لكن الناس كانت في تلك الفترة تعتقد وتؤمن بمثل هذه الأقوال والمعتقدات. إصرار والدي على هذه التسمية أغضب جدي.
كان والدي رحمه الله جريئا في رأيه ومعتقداته، وله قصص كثيرة تؤكد ذلك. فيما كان جدي طاهر، رحمه الله، أيضا قوي الشكيمة، وحازما في تربية أبنائه.
كان والدي هو الرجل التنفيذي لمشاريع العائلة السياسية. ففي الوقت الذي كان فيه لعمي حكمت التمثيل والدور السياسي للعائلة، كان لوالدي الدور المركزي في تنفيذ هذه الخطط، معتمدا في ذلك على شخصيته الكاريزماتية من جهة، وشبكة العلاقات التي تمتد إلى كافة مساحات النفوذ السياسي عاموديا، والطبقات الاجتماعية أفقيا.
طبعا، كانت نابلس ذلك الوقت تشهد تنافسا سياسيا واقتصاديا بين العائلات. عائلات شرق نابلس وعائلات غربها. حتى إن هذا التنافس أو التعارض أخذ طابعا مميزا في اللباس، ففريق يرتدي الطربوش، يناكفه فريق آخر، يرتدي الحطة والعقال، وهي إشارة على تقدمية اتجاه، وكلاسيكية آخر.
ولهذا التنافس ارتباط بتحقيق نفوذ ومصالح انتخابية أو اقتصادية، لكنه لم يكن تنافسا جهويا، بالمعنى السلبي، بل كان تنافسا على زعامة عائلية أو مناطقية، وعلى حصد مقاعد مجلس النواب، بالحد الأقصى، أو تصدر وجاهة نابلس.
الصراع على النفوذ كان بين اي العائلات في نابلس؟
هو ليس صراعا، بل تنافس؛ فالحياة في نابلس كانت بسيطة، والعلاقات بين الناس كانت أكثر من رائعة، والروابط الانسانية التي تجمعهم، تتعدى النسب والمصاهرة، فهم شركاء في كل شيء.
لكن ما أعلمه جيدا، بأن رئيس البلدية سليمان طوقان، كان رجلا مهما، استمر في موقعه لـ 27 عاما، ثم أصبح وزيرا للدفاع في أواخر الخمسينيات، وكان وزيرا اتحاديا، وقتل في بغداد. كما كان هناك أحمد الشكعة، اضافة لشخصيات من عائلات كنعان وعبد الهادي وأخرى. وبقي هذا التنافس بين العائلات، حتى في خضم تصاعد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. كان الانتداب البريطاني يشجع هذه الصراعات، لإلهاء الناس عن تلك الهجرة. وانتخابات بلدية نابلس العام 1947 شهدت تنافسا شديدا.
بعد هذه الانتخابات بعام حصلت نكبة العام 1948، فكيف تابعتها بعيني طفل؟
نعم كنت طفلا، لم يتجاوز الخمسة أعوام. واتذكر أعداد اللاجئين الكبيرة، ممن تدفقوا من مدن وقرى فلسطين إلى الضفة الغربية؛ كانت أعدادا كبيرة جدا، وملأت هذه الأعداد المدارس والمساجد. لم أكن أعرف، وأنا في ذلك العمر، ما الذي يحصل. لكن كنت اتابع كيف أن هذا العدد الكبير ملأ الدنيا، وكيف كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة. اقل ما يمكن قوله فيها، هي انها ظروف تشريد ولجوء صعبة، ولم يكن لاحد من اللاجئين ان يحتاط لتلك النكبة، وأن ياخذ معه ما يعينه على هذه الهجرة القسرية.
ما أعلمه جيدا في ذلك التاريخ، بأني تأخرت سنة دراسية كاملة، حيث لم اتمكن من الالتحاق بالصف الأول، بسبب إقامة اللاجئين في مدارس نابلس. كما كانوا أيضا يملأون المساجد.
وهو حال عاشته الضفة الغربية، بألم وحسرة وإحباط. أذكر كيف أن هذا الحدث كان شاغلا للناس كلها. كنت طفلا صغيرا، أصغي لهذا كله باستغراب، فأنا أشعر أن هناك خطرا كبيرا، وأشعر بأن الناس خائفون، لكني لا أفهم ما الذي يجري حولي، بالمعنى السياسي.
وكيف دخلت المدرسة بعد عام من هجرة اللاجئين؟
بعد عام، أو خلال 15 أيار (مايو) من العام 1948 بدأ اللاجئون يسكنون مخيمات بعيدة عن المدينة القديمة، واختاروا لأنفسهم نمط حياة، يتماشى مع الظرف الجديد لهم، والذي كانوا يتوقعون أنه لن يطول. لذلك لم تكن هناك مظاهر استقرار في تلك المخيمات.
ثم دخلت المدرسة، وانتظمت بالصف الثاني الابتدائي مباشر.
ولماذا اختاروا لأنفسهم نمط حياة مختلفا؟
هذا عائد لطبيعة الاختلاف الثقافي بين أهل الساحل وأهل الجبل، وهو اختلاف سببه اشتباك أهل الساحل بالثقافات المتعددة، فهم معبر بحري، وبالتالي نمط حركة النقل يأتي بكل العالم إليهم، ومن هنا، قد يكون لهم رأي آخر في نمط معيشتهم في مدنهم، أما أهل الجبل، فهم محافظون ومتمسكون اكثر بالعادات والتقاليد، الموروثة عن الآباء والأجداد.
لذلك يمكن القول إن هناك فروقا طفيفة تتعلق بالمنطقتين، وكل يتعصب لمساره الاجتماعي، من خلال تمسكه بنمط حياته.
ثم إن هناك سببا آخر، لعله يعود لطبيعة الظرف، فقد كان هؤلاء اللاجئون يعيشون حياة مستقرة ومزدهرة في مدنهم وقراهم، وفجأة وجدوا أنفسهم مشردين، بدون مأوى، وفي ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة. التشرد حرمهم من الحياة المستقرة، واضطرهم لأن يخطوا لأنفسهم نمطا جديدا من الحياة، لأن تراثهم وأملاكهم بات وراءهم، وصراع البقاء، الذي يعيشونه، ومواجهة التحديات؛ كل هذه العوامل هي التي حددت لهم طريق الحياة.
إلى جانب كل ذلك، فهم اختبروا الصراع الصهيوني مبكرا، ويفصلنا عنهم (في الضفة الغربية) نحو 45 كلم، فهم تعرفوا على مظاهر الاحتلال قبلنا، عبر وجود "الكبانيات" التي يسكنها يهود، لذلك يمكن القول بأنهم تقدموا عنا مدنيا، أو أن هناك تفاوتا لصالحهم، أو قد أراه لصالحهم.
كيف لنابلس أن تكون بيئة محافظة، وهي مدينة اشتبكت مع الحضارات، وقد كان للحركة التجارية فيها شكل من اشكال الاحتكاك بالآخرين؟
لا أعني بالبيئة المحافِظة ما قصدته أنت. المحافِظة في هذا السياق لا تتعدى التمسك بالموروث من العادات والتقاليد، أما عن حركة العائلات فقد كانت حرة وميسرة.
لكن إذا أردت أن أقول عن مظهر واحد من مظاهر تلك البيئة المحافِظة، لقلت أنّ لباس النساء في تلك المرحلة كان فيه شيء من الالتزام بالمظهر المحتشم. كانت أمي ترتدي خمارا على وجهها إذا خرجت من المنزل.
وكان هناك فصل حذر بين الرجال والنساء، فكانت النساء، مثلا، تلجأ لعقد الاجتماعات ضمن ما كان يسمى بـ"الاستقبال"، وهو اجتماع لنساء الحارة أو العائلة، يعقد كل شهر مرة، في منزل احداهن.
وكانت بعض تلك "الاستقبالات" مكانا لعزف العود والغناء والرقص، وطبعا تدخين النرجيلة. كل ذلك كان يتم على الرغم من الفصل الحذر بين الرجال والنساء، لكن من دون أي تزمت. الاحتشام للمرأة، مثلا، كان احتراما لهذه التقاليد.
طبعا، هذه الاجتماعات أو "الاستقبالات" قد تنعقد لأكثر من مرة في الشهر، خصوصا إذا كانت الأمور الاقتصادية في بحبوحة، فقد يكون الاجتماع مرتين في الشهر أو أكثر، وهو استقبال كان عادة يعقد مساء، والنساء كن ملتزمات بهذا الموعد. لا أقلل بأي حال من الأحوال من شخصية المرأة النابلسية، وهي شخصية قوية، ساعدت على أن تأخذ دورا رياديا في المجتمع، وقد سجلن لأنفسهم حضورا في المواقع القيادية، حتى في ذلك الوقت.
المرأة النابلسية معروفة بقوة الشخصية، وحُسن الإدارة لبيتها، وعائلتها.
عودة للمدرسة، بعد أن تأخرت عاما عن الالتحاق بالصف الأول كيف دخلت المدرسة؟
درست في كلية النجاح الوطنية، وهي مدرسة خاصة كانت تحظى بسمعة طيبة في كل فلسطين، بل وبدون مبالغة، كانت تحظى بسمعة عربية طيبة، فقد درس فيها أبناء زعامات سياسية، جاءت من المغرب، بعد أن تم نفيهم في عهد الفرنسيين.
طبعا أنا الوحيد من بين إخوتي، الذي درس في مدرسة في نابلس، ولم يقم والدي رحمه الله بتسجيلي بمدرسة داخلية، في القدس أو رام الله، وكان ذلك بسبب أني الابن الأكبر، وبالتالي يجب أن أظل ملازما لوالدي، وهي مسؤولية الابن الأكبر دائما.
وهو وضع رافقني حتى انتهاء الثانوية العامة، وسفري للدراسة في الخارج.
مدرسة كلية النجاح الوطنية كانت تزخر بالمعلمين الأكفياء، وهم على سوية عالية من المهنية التعليمية، كما أنهم كانوا محترفين في العمل السياسي.
لذلك، فهذه المدرسة لم تخرج الطلبة بكفاءة عالية فقط، بل إن الحكومات كانت تختار من بين معلميها وزراء. ولما سجلني والدي في المدرسة، كان مديرها العام قدري طوقان، الذي كان يسمى بالعلامة، وهو خريج جامعة اكسفورد في ذلك الزمن، ليصبح وزيرا للخارجية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.
كما كان من المعلمين الذين يشار لهم بالبنان، والذكرى الطيبة، عبد القادر الصالح، الذي كان نائبا معارضا، ثم وزير دفاع، وهو شخصية معروفة.
لقد تعلمنا على أيدي معلمين أصحاب حرفية مهنية، وموقف سياسي واضح في الحياة العامة. كانت مهابتهم تجبرنا على أن ندخل الصفوف، وفي قلوبنا رهبة التلميذ من معلمه، والقائمة على علم هؤلاء، لا بطشهم أو سيطرتهم.
كان وضع المعلم في ذلك الزمن وضعا مهيبا، فهو ينتمي إلى الطبقة الوسطى، بحكم دخله الشهري الذي يسمح له بأن يظل محافظا على طبقته ومكانته الاجتماعية. الصورة الأنيقة للمعلمين ما تزال حاضرة في ذاكرتي.
هل كان في المدرسة معلمون عرب أو من الأردن؟
في كلية النجاح، وهي مدرسة خاصة، لم يكن هناك مدرسون من خارج فلسطين، لكن قد يكون توفر ذلك في المدارس الحكومية، والتي لم تكن تقل كفاءة تعليمية عن الخاصة.
فالمدرسة الصلاحية، وهي حكومية، كانت تحظى بسمعة غاية في الاحترام، وقد كان يأتيها الطلبة من خارج المحافظة، وحتى من الأردن. أذكر أن مدير مدرسة الصلاحية كان النائب عن مقعد نابلس في وقتها عبد الله الخطيب، وللمصادفة هو من أخذت مكانه عن المقعد الشاغر لنابلس، بعد أن توفاه الله، وجرت انتخابات تكميلية داخلية في مجلس نواب، العام 1973.
وماذا تتذكر من المدرسة، وهل لها دور في صياغة شخصيتك السياسية؟
نعم؛ أنا درست في كلية النجاح من الصف الثاني، وحتى إنهاء مرحلة الثانوية العامة. كان للمعلمين أثر مباشر في تحفيز وعينا السياسي، لكن الأثر الأكبر لتكوين شخصياتنا، كان طبيعة الأحداث منذ النكبة وحتى لحظة سفري للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية مطلع ستينيات القرن الماضي.
كان للمد القومي في الخمسينيات، وبروز نجم الزعيم المصري جمال عبد الناصر، وطبيعة الأحداث التي تدور على أرض فلسطين ذلك العقد، وحركة الانقلابات العسكرية الدائرة في العالم العربي، أثر في صياغة شخصياتنا. كما تأثرنا بمواقف المعلمين، أمثال الاستاذ محمد العمد، وشاكر ابو حجلة، وقصي هاشم، والشيخ أسعد شرف. فضلا عن أنني من عائلة سياسية، انخرطت بالعمل العام مبكرا، وكان لوالدي وأعمامي نشاطات مختلفة على هذا الصعيد.
لعل بقائي بالقرب من كل هذه الأحداث، أثر في وعيي المبكر كثيرا، بل كنت أحيانا اتعاطى مع هذه الهموم بانفعال بالغ وتأثر شديد.
لقد صاغت تلك الأحداث وجداني وطبعت شخصيتي بهوية فلسطينية عربية قومية. فلم أكن أقل انفعالا تجاه أي قضية عربية من انفعالي تجاه أي تطور يجري على أرض فلسطين.
استقينا التربية السياسية والوطنية من تلك الفترة، التي كانت مُشبعة بالهموم والحروب، وحالات عدم الاستقرار. كما أن المد القومي كان يأسر، بلغته ومواقفه وشعاراته، قلوب الشباب اليافع.
لقد خفت من ضعف قدرتي، وقتها، على التوفيق بين كل هذه الهموم، بذات التركيز والقدرة على المتابعة، لكني سعيت لأمزج بين أن أعيش هم من اقتُلع من أرضه؛ وأعيش جبروت الصامد على أرضه، وهو أمر لم يكن سهلا عليّ أبدا، بل وتسبب لي بحالة نفسية مركبة، نتيجة التعايش مع تلك الظروف في مقتبل العمر، ففي ذلك السن تحديدا يتشرب الإنسان المعرفة، وتستقر في قلبه، وقد كانت المعرفة والعلم في تلك المرحلة كلها هم فلسطين وهموم العرب.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved