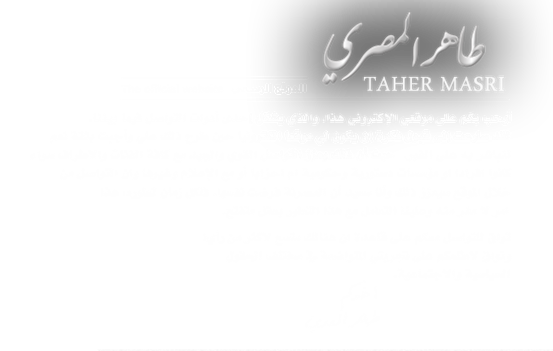

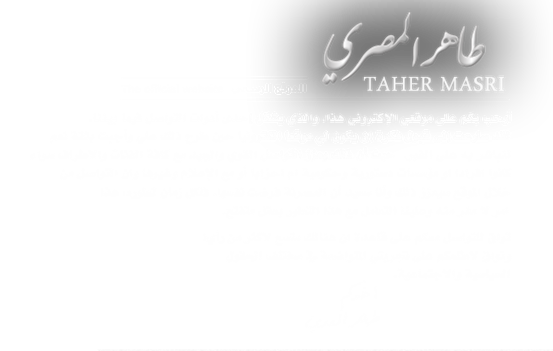

عشر سنوات على انطلاق العملية الديمقراطية في الأردن
ألقيت هذه الكلمة في الجلسة الافتتاحية لندوة واقع وآفاق تطور العملية الديمقراطية في الأردن بدعوة من مركز الأردن الجديد بتاريخ 6/9/1999
تصادف هذا العام، وتحديداً في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الذكرى السنوية العاشرة لانتخابات مجلس النواب الحادي عشر في عام 1989، وهي الانتخابات التي كانت فاتحة لعملية تحول ديمقراطي سارت خلال العقد الأخير بخطوات متعرجة من الصعود والهبوط، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم.
ونحن إذ نشكر مركز الأردن الجديد للدراسات الذي أتاح لنا الفرصة لمراجعة مسار هذه التجربة واستخلاص دروسها، وذلك في إطار السعي لاستشراف آفاق التطور الديمقراطي المستقبلي في بلادنا، فإن من حقنا أن نعرب عن أسفنا لأن هذه الذكرى العاشرة لم تحظ حتى الآن بما تستحقه من اهتمام، سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد مؤسسات المجتمع المدني، رغم ما تمثله من فرصة ثمينة للمراجعة، على طريق بلورة توافق وطني حول متطلبات تجديد انطلاق العملية الديمقراطية. بالزخم الذي يتفق مع التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة، وطموحات العهد الجديد على مشارف الألفية الثالثة، بكل ما يحمله شعبنا تجاهها من آمال في عالم جديد تسوده الحرية والعدالة والازدهار.
لقد شكلت انطلاقة التحول الديمقراطي تعبيراً موضوعياً عن طموحات التغيير عند الشعب، والتي تجاوب الحكم معها، فقد ناضلت الحركة الشعبية على امتداد الثمانينيات من أجل التغيير الديمقراطي وكثفت بعد أحداث نيسان (إبريل) 1989 في تناغم منقطع النظير، من مطالبها السياسية من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي.
في هذا الاتجاه، فإن الحكم بما توافرت لديه من تجربة ومرونة، مستشرفا آفاق الموجة الديمقراطية التي اجتاحت العالم، أخذ بخيار التلاقي مع المطالب الشعبية، باعتباره أقصر الطرق لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية التي كانت قد بلغت ذروتها مع نهاية العام 1989، فكانت هذه المحطة مناسبة لإعادة هيكلةٍ جزئية للنظام السياسي، وتجديد الشرعية الشعبية للحكم.
وربما ينبغي القول إن إدراك التيار الشعبي العريض ووعيه للظروف الجديدة وتجاوبه معها كانت متفاوتة، ولذلك ساد الشك نظرته إلى عملية التحول؛ إذ نظر إليها كما لو كانت مجرد انعطافة مؤقتة لامتصاص حالة الاحتقان، وقد تأثرت هذه الأحكام بشكوكه القديمة تجاه سياسات الحكم، وبإحباطاته من الحركة السياسية، لذا لم تنجح العملية الديمقراطية في اجتذاب مختلف قطاعات الشعب إلى دائرة المشاركة، ودمجها في اصطفافات جديدة على أساس خيارات سياسية واقتصادية محددة، مما أبقى مساحة التأثير للولاءات الجهوية والإقليمية والعشائرية والطائفية واسعة.
مرحلة النهوض 1989-1993:
تشكل مرحلة 1989-1993 المرحلة الأهم والأكثر إشراقاً في عملية التحول الديمقراطي، فقد جاء مجلس النواب الحادي عشر قوياً إلى حد ما في تكوينه وفي مظاهر التعددية داخله، إذ اشتمل على سائر الألوان السياسية، وبحضور فاعل للتيارات الإسلامية والقومية واليسارية.
هكذا تمكن مجلس النواب حينها، وفي القسم الأكبر من ولايته، من تكريس استقلاليته إزاء السلطة التنفيذية، ومارس الرقابة على الأداء الحكومي بكل ما تتضمنه من مساءلة ومناقشة للسياسات، وشارك بفاعلية في صنع القرار وإصدار تشريعات جديدة ليبرالية أو ديمقراطية الطابع، لاسيما تلك المتعلقة بالأحزاب والمطبوعات والنشر ومحكمة العدل العليا، وتم في عهد هذا المجلس إلغاء القوانين الاستثنائية، وفي مقدمتها الأحكام العرفية وقانون الدفاع لسنة 1935، وقانون مكافحة الشيوعية وغيرها.
كما حقق هذا المجلس في عدد واسع من ملفات الفساد، مما أثار حفيظة بعض مراكز القوى التي اعتبرت أن المجلس تجاوز الخطوط الحمراء، وهذا الموقف شكل في نتيجته عنصر ضغط على العملية الديمقراطية، وبدأ البحث عن بديل لقانون الانتخاب ساري المفعول في حينه.
لـــقد شهدت هذه المرحلة مصالحة تاريخية بين الحكم والقوى السياسية، وبين القوى السياسية نفسها، فتحت مظلة الحكم تمت بلورة عقد اجتماعي جديد من خلال المثياق الوطني، بدءًا من اللجنة الملكية التي كُلفت بصياغته، والتي جاءت ممثلة لمختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وانتهاء بوثيقة الميثاق التي حملت مضامين توجيهية متقدمة لمختلف مناحي الحياة في الأردن، وكان من شأن تفعيل المــيثاق في الحياة الوطنية تعميق التحول الديمقراطي وتكريسه، وترسيخ وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره.
في هذا المناخ من المصالحة الوطنية والانفراج، تعرض الأردن لتحديات حرب الخليج 1990/ 1991، فأثبت قدرة فائقة على اتخاذ موقف مستقل من الأحداث، وحافظ على استقراره وأمنه، رغم أنه كان يقف في الخندق المقابل لحلفائه التقليديين، وبالتأكيد كان لهذه الاستقلالية في الموقف ثمن، وبخاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي، ولذلك شكلت نتائج الحرب عناصر ضاغطة على العملية الديمقراطية على أكثر من صعيد.
مرحلة التراجع 1993-1998:
كما هو معروف، شهدت العملية الديمقراطية منذ النصف الثاني من العام 1993 نكسة حقيقة، تجلت أبرز مظاهرها في فرض نظام الصوت الواحد للناخب بقانون مؤقت صدر من وراء ظهر مجلس النواب، بعد أن كان قد أنهى دورته الرابعة والأخيرة، كما تجلت في التجميد الفعلي لروح المصالحة الوطنية التي مثّلها الميثاق الوطني، وإغلاق أبواب الحوار الوطنيوتقييد الحريات العامة، لاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وازدياد مظاهر التطاول على حقوق الإنسان وحرياته.
وبرغم محالاوت الحفاظ على الحد الأدنى من استقلالية مجلس النواب الثاني عشر المنتخب في العام 1993، إزاء السلطة التنفيذية، إلا أن المجلس فشل في صيانة هذه الاستقلالية وتكريسها بالشكل المطلوب، هكذا تم تحويل العملية الديمقراطية إلى مجرد قشرة خارجية خالية من الروح والمضمون الديمقراطيين، صحيح أن الانتخابات النيابية الدورية تواصلت، وكان هناك مجلس نواب منتخب، وتعددية سياسية وحزبية قائمة، إلا أن قوة الدفع الوطنية للتحول الديمقراطي شُلّت تماماً، فجُمدت العديد من مشاريع القوانين المتقدمة أو وُضعت على الرف، وانفتحت شهية بعض الحكومات على إعادة النظر في التشريعات الليبرالية، وافتعال المعارك الجانبية مع مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الأحزاب والنقابات المهنية والصحافة، كما تقلصت مساحة الشورى والمشاركة، وبلغ هذا المنحى ذروته بصدور قانون المطبوعات والنشر المؤقت لسنة 1997، والذي جاء بمثابة انقلاب على الحريات الصحفية إلى درجة مصادرة حرية التفكير، والتسبب بإغلاق (13) صحفية أسبوعية دفعة واحدة.
أسباب تراجع العملية الديمقراطية:
على الصعيد الداخلي، أثار الزخم الذي مثله مجلس النواب الحادي عشر، وتجاوزه لما اصطلح على تسميته ”الخطوط الحمراء"، حفيظة القوى المحافظة التي تكاتفت للحيلولة دون تكرار التجربة، مستفيدة من الفرص التي أتاحها نظام الصوت الواحد الذي أنعش العصبيات التقليدية في بنية المجتمع على حساب عصرنة الحياة السياسية.
هذه القوى الاجتماعية كانت المستفيد الأول في مرحلة الأحكام العرفية، واضطرت في مرحلة المد الديمقراطي إلى مواكبة المرحلة، وتصدر تجلياتها السياسية حتى لا تفقد نفوذها وامتيازاتها، وقد تعلمت هذه القوى لغة سياسية جديدة ذات مفردات ديمقراطية، فأصبحت تحارب الديمقراطية باسم الديمقراطية نفسها.ولأن هذه القوى تفتقد المصداقية في أعين الشعب، فقد لعبت دوراً محبطاً ومعيقاً لتطور العملية الديمقراطية، ومثلت رأس حربة في احتواء الانطلاقة الديمقراطية في مرحلتها الأولى، ومما ساعد على ذلك أن الحركة السياسية بمكوناتها القديمة والجديدة، لم تنجح في تطوير برامجها على النحو الذي يبقيها طرفاً محركاً للنهوض الديمقراطي.
أما على الصعيد الخارجي، فقد شكلت معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية ومتطلبات إقرارها والالتزام بمضامينها، عنصراً مقيداً للسير في طريق الديمقراطية، ولا تكمن المشكلة في مبدأ التسوية السياسية والتوجه إلى لإحلال السلام على جميع مسارات التفاوض العربية–الإسرائيلية، ومنها المسار الأردني، بل إن وتيرة السير السريعة على هذه الطريق قد مثلت إشكالية بحد ذاتها، إذ إنها عززت نزعة إدارة الظهر للرأي العام، وتجاهل ضرورات الحوار الوطني حول قضايا مصيرية تهم الناس جميعاً، وضاقت أكثر فأكثر حلقة صناعة القرار، فأصبحت محصورة في نطاق أضيق وبأيدي القلّة، إضافة إلى التضييق على الاتجاهات المعارضة لعملية السلام، أو تلك التي لديها تحفظات معينة على جوانب محددة منها.
في المحصلة، فإن التأثيرات السلبية لعملية السلام على حالة الانفراج الداخلي في المملكة، كانت كبيرة، فالعملية السلمية لم تكن تعني الصلح مع إسرائيل فقط، وإنما كانت تعني أيضاً تعديلات جوهرية في السياسة الخارجية، وفي منظومة التحالفات الإقليمية؛ مما ألقى بظلاله الثقيلة على علاقات الأردن العربية.
وبالنتيجة، عززت عملية السلام الانقسامات الداخلية، وأشكال الخندقة حول المواقف، وكرست تراجع مناخات الحوار الوطني إلى نقطة الصفر، وساهم ذلك في الحد من تطور الحركة السياسية التي تحتاج في ظروف الديمقراطية إلى انفتاح حقيقي متواصل، كي تكون شريكاً في تحمل المسؤولية عن حاضر الوطن ومستقبله.
في أجواء الاحتقان السياسي التي سادت في صيف العام 1997، ولاسيما بعد أن أقدمت الحكومة على إصدار قانون مؤقت وغير دستوري للمطبوعات والنشر، بكل ما مثله ذلك من استهانة بمجلس النواب والرأي العام، تبلورت فكرة مقاطعة الانتخابات النيابية كإجراء دفاعي وتحذيري، لكن بدل أن تراجع الحكومة توجهاتها وتستجيب لدعوات الحوار الحقيقي للخروج من المأزق، أمعنت في سياساتها غير الديمقراطية، وفي التضييق على الخصوم السياسيين أو معاقبتهم.
وجاء صيف العام 1998 ليكشف عن مدى التدهور الذي بلغته الأمور، ومدى الخداع الذي مارسه المسؤولون مع ظهور حقيقة معدلات النمو الاقتصادي، وأزمة تلوث المياه، ثم لجوء الحكومة إلى تقديم مشروع قانون رجعي للمطبوعات والنشر، وتمريره في البرلمان بعد أن قضت محكمة العدل العليا بوقف العمل بالقانون المؤقت لسنة 1997 لعدم دستوريته.
تحديات التحول الديمقراطي:
لا بد بداية من دحض بعض المقولات المضللة حول عدم جاهزية المواطن العربي عموماً للسير في ركاب الديمقراطية، والتي يعزوها أصحاب هذه المقولات إلى أسباب حضارية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، ومن يروج لهذا النمط من المقولات لا يمكن أن يكون ديمقراطياً وهو يستهدف في واقع الحال إعادة الأمور إلى الوراء، وتعطيل تقدم العملية الديمقراطية.
من ناحية أخرى، فإننا إذ ندعي أن حالنا في مجال الديمقراطية أفضل من حال غيرنا، لا نكون قد جانبنا الصواب، فهذا استنتاج صحيح، لكن لا ينبغي أن يشكل ذلك بأي حال من الأحوال مدخلا لتبرير بعض مظاهر التراجع عن الديمقراطية، أو وقف التطور عند حدود الانفراج السياسي.
ولا شك في أن الديمقراطية عملية تراكمية، فلا يمكن للمجتمعات أن تتحول إلى مجتمعات ديمقراطية بين ليلة وضحاها، لكن من المهم أن يبقى خط سير التحول الديمقراطي صاعداً، حتى وإن كان تدريجياً وطويل المدى، أما التذبذب في المسيرة الديمقراطية، وإبقاؤها عرضة للتراجع والانتكاس أو للمزاجية والظروف الآنية، فإنه يلحق أضراراً فادحة بالمصالح الوطنية العليا.
وهنا ربما ينبغي التأكيد على الضرورة القصوى للتميز بالنسبة للأردن، بما في ذلك في المجال الديمقراطي، ودعونا نتذكر أن الأردن نجح بعد الاستقلال في التميز عن العديد من الدول العربية بنظامه الإداري، وفي بناء بنيته التحتية، وفعالية برامجه التنموية.وقد استمر هذا الوضع سنوات عديدة، مما ولد طلباً عالياً على اليد العاملة والخبرات الأردنية، بمردود اقتصادي بلغ مليارات الدنانير، إضافة إلى تأثير كبير، معنوي وسياسيفي المنطقة أما الآن، فإن التميز الأردني الذي استمر لعدة عقود على امتداد الفترة من الخميسنيات إلى الثمانينيات، قد أخذ يتراجع، وراحت الدول التي تعلمت منا تسبقنا. وهذا ما قد يحدث إذا ما بقي التردد سائداً بشأن العملية الديمقراطية، فهناك تغييرات متنامية تجتاح العالم العربي، وتدخل في نطاق التكيف والتأقلم مع عوامل ضاغطة، محلية وخارجية.
تحديات في مواجهة التحول الديمقراطي
التحديات التي تواجه عملية التحول اليمقراطي متعددة، أهمها:
أولاً: على صعيد المجتمع المدني
بعد عشر سنوات على التحول الديمقراطي، لم يبلغ المجتمع المدني مستوى أداء دور حاسم في مجرى العملية الديمقراطية، فدور البرلمان بقي محدوداً، فيما انحصر تأثير مؤسسات المجتمع المدني في مجالات فعل ضيقة.
ولعل من الأهمية بمكان أن أعطي مثالاً على إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي البلديات التي ضعف دورها بشكل كبير، برغم أنها من أهم المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطن وتطوير البلد. فهناك حوالي 80% من سكان المملكة يعيشون في تجمعات كبيرة أو متوسطة، ويواجهون مشاكل حياتية جمة، يقع عبء حلها على البلديات، لكن البلديات التي ما تزال تمثل في معظمها مساحات للتنافس العشائري، لا تقوى على النهوض بالدور المنوط بها، طالما بقيت هياكلها ضعيفة، وديونها كبيرة، واستقلاليتها محدودة، ودورها في التنمية الشاملة مسلوباً، ولذلك فإن تكريس المنهج الديمقراطي في حياة المجتمع الأردني يتطلب إعادة هيكلة للبلديات وصلاحياتها ودورها، بحيث تصبح الخطوة الأولى والمهمة في تنظيم حياة المواطنين، وتصبح القائد والمثال الحسن لمؤسسات المجتمع الأهلية.
لقد قطع الأردن أشواطاً واسعة في التحديث ومواكبة العصر، لكن سلطاته المحلية ما تزال تعمل وفق أنماط إدارية قديمة، مما ينعكس سلباً على مجمل حياة المجتمع المدني التي باتت بحاجة إلى إصلاح جذري.
ثانياً: على صعيد وحدة المجتمع
هنا أريد تسليط الضوء على ضرورة تأكيد مفهوم الدولة، فقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية ممارسات تقزم مفهوم الدولة، ليصبح مفهومها محسوباً وممارساً من خلال مصالح ضيقة؛ سواء كانـــت شخصية أو عشائرية أو جهوية، والتعامل مع الدولة انطلاقاً من هذا المفهوم البدائي والزاوية الضيقة، يؤدي باستمرار إلى شرذمة المجتمع، وإضعاف الجهد الوطني بشكل عام وتشتت الجهد، كما يجعل المواطن عرضة للخوف والشك وعدم الاستقرار، وهذه هي حالنا اليوم، وسيكون بإمكان أعداء الأردن النفاذ من نقطة الضعف هذه في الوقت المناسب، إذا ما أرادوا الإضرار بنا وإذا ما بقينا على حالنا. ومعياري في قياس مدى الانتماء للوطن ينطلق من هذه النقطة بالذات، مدى إدراك المسؤول والمواطن والتزامهما بمفهوم الدولة الحقيقي.
في كل المجتمعات، هناك جماعات وأفراد تحاول تحقيق مكاسب شخصية لها، ولكن يحكمها ناظم عريض يسمى مفهوم الدولة، لا يسمح لأي منها تجاوزه وكلما كان المجتمع ملتزماً بهذا المفهوم بإطاره العريض، كانت الدولة -أفراداً وجماعات ومؤسسات- مستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والمقارنة سهلة وواضحة فيما بين دول العالم الصناعي التي رسخ لديها مفهوم الدولة، وبين دول العالم الثالث التي ما يزال مفهوم الدولة لديها يتأرجح بين مصالح وآراء الحكام والفئات الاجتماعية والثقافية المختلفة.
إن تكوينات المجتمع الأردني الديموغرافية والثقافية والدينية، توفر له تعددية يمكن أن تكون مصدر إثراء لحياته السياسية والثقافية والاجتماعيةإذا ما انصهرت هذه التكوينات في بوتقة الديمقراطية التي تكفل للشعب وحدته، وللبلاد أمنها واستقرارها، وللوطن القدرة على مجابهة مختلف التحديات، في المقابل فإن غياب الديمقراطية أو ضعفها يعرض النسيج الاجتماعي للضعف، ويهدد وحدة المجتمع ويعرضه للتفسخ، لاسيما إذا ما أخذنا بالاعتبار موقع الأردن الجغرافي وصعوبة أوضاعه الاقتصادية، وعلاقته العضوية بالقضية الفلسطينية.
ولذلك، فإن الأردن لا يستطيع تجنب تأثير التغييرات العاصفة في المنطقة، إلا بتماسك مجتمعه في ظلال الديمقراطية، وتحمل مؤسسات المجتمع المدني، بترابطها واستقلاليتها، واجباتها في حماية الجبهة الداخلية والتمسك بمبدأ أن يتمتع الإنسان الأردني فعلاً بحق المواطنة الحقيقية، وأن يصبح شريكاً فعلياً في إدارة شؤون وطنه ودولته هو مبدأ أساسي، ولا تستقيم الأمور الديمقراطية الحياتية إلا بتحقيق هذا الهدف.
إن النهج الديمقراطي هو وسيلة المجتمع الأولى لضمان وحدته الوطنية، وإذا كانت هذه الوحدة تعني غالباً وحدة المواطنين، بغض النظر عن أصولهم الأردنية أو الفلسطينية، فإن هذه الوحدة هي النقيض لمختلف أشكال الشرذمة؛ سواء في علاقات الدولة مع مواطنيها، أو في التفكير الفئوي الذي قد يحرك وزيراً أو نائباً أو سياسياً أو رجل أعمال، هذا فضلاً عن أن هذه الوحدة هي صمام الأمان في مواجهة النزاعات التي قد تنشأ على هامش انقسامات المجتمع على كافة الصعد، الاجتماعية والسياسية والدينية ما بين غني وفقير، ويساري ويميني، ومتدين وعلماني... إلخ.
ثالثاً: على صعيد الحياة السياسية والمشاركة
ينتمي جميع أفراد المجتمع إلى تكوينات أو روابط أولية طبيعية؛ جهوية أو عشائرية أو عائلية أو دينية.ولكن الديمقراطية تؤمن بإعادة اصطفاف الأفراد بناء على أفكار ورؤى ومصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولذلك فإن كل التوجهات أو الإجراءات التي من شأنها تسييس الانتماء الجهوي أو العشائري أو العائلي أو الديني، إنما تلحق الضرر بالعملية الديمقراطية، وتضيق سبيل الانتماء السياسي الوطني العام.
ولعل مما يضاعف من مخاطر تسييس الانتماءات والروابط الأولية، أننا نعيش كما هي حال البلدان النامية عموماً، في مجتمعات أبوية، تشوه أصول التنمية السياسية وفرز القيادات السياسية بشكل طبيعي وسلس. وإذا ما أضفنا إلى ذلك طول المدة الزمنية التي صودرت فيها الحريات العامة والديمقراطية، فإن ذلك يفسر قلة عدد الشخصيات السياسية ذات الحضور العام التي أفرزتها الحركة الشعبية مقارنة مع ما كان عليه الحال مثلاً قبل الستينيات.
فقد اقتصرت الشخصيات السياسية ردحاً طويلاً من الزمن على موظفين عملوا في الحقل العام؛ كالوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظين وكبار العسكريين وغيرهم. أي أن الحكومات كانت هي المصدر الرئيس لتفريخ القيادات السياسية، وهي صانعة النجوم السياسيين. وقد ترك ذلك بصماته الواضحة على معظم الأحزاب الجديدة التي تأسست بعد عام 1992، إذ كان للوزراء أو المستوزرين نصيب الأسد في قياداتها من النفوذ والتأثير.
ويلاحظ كذلك أن فئات البرجوازية الليبرالية تخلفت عن ممارسة دورها كعنصر انفتاح وتأثير ليبرالي على السياسات الحكومية، وذلك بحكم تداخل مصالحها مع تلك السياسات، وحتى حين انضمت رموز من هذه الفئات إلى الحركة الحزبية، فقد كانت أقرب إلى النهج المحافظ في أدائها وفي الالتزام بالمحافظة على سياسات الأمر الواقع.
لقد خلق هذا التطور المشوه في الحياة السياسية فراغاً لا يسهل ملؤه، ذلك أن التطور الطبيعي كان يفترض أن يقود إلى خلق قيادات وطنية تحظى بثقة المجتمع، لكننا نشهد حقيقة أن معظم التشكيلات الحزبية معزولة عن القطاعات الواسعة من الشعب، فيما توجد زعامات استمدت نفوذها من مواقعها السابقة في دوائر السلطة، أو من ثقلها الاقتصادي–الاجتماعي، لكنها لا تمتلك المصداقية الكافية كشخصيات قيادية، أو أنها عاجزة عن تكوين أحزاب أو تيارات فاعلة ومستمرة.
إن تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، يتطلب وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة، في مقــدمتها بطبيعة الحال الأحزاب السياسية؛ فالحزب السياسي في بلد ديمقراطي هو أساس الحياة السياسية، لكن النظرة الرسمية للأحزاب من حيث المبدأ، ما تزال تتجاهل دورها في المشاركة وتداول السلطة، في الوقت الذي ما تزال الأحزاب أيضا غير مؤثرة في الحياة السياسية، مما يضعف قناعات الناس بالحاجة إلى الأحزاب، ويعزز عزوفهم عن الانخراط فيها.
وكلما زادت الحياة السياسية والاجتماعية تعقيداً، فإن هذا يعطي الحكومات نفوذاً أوسع في الحياة السياسية، ويضعف تأثير الأحزاب السياسية، وفي الوقت نفسه، فإنه كلما اتسع نطاق التسييس للعشيرة، ضاقت الحزبية في البلد، ومما يفاقم من ضعف الأحزاب وحشرها في مساحة محدودة من عالم العمل السياسي وضعف تطور البنى الحزبية والذهنيات الحزبية السائدة.
رابعاً: على صعيد الفساد الإداري والمالي
الفساد هو أحد مظاهر الخلل التي عانى منها الجسم الأردني خلال العقود السابقة، وفي السنوات الأخيرة، وقد أصبحت محاربة الفساد تحتل موقعاً مهماً في برنامج الحكومات المتعاقبة، وقد جرت العادة أن ينظر إلى الفساد باعتبار أن أقطابه هم من صلب الجهاز الحكومي والقطاع العام، لكن الرأي العام بات يدرك الآن أن الفساد لا يقف عند هذا الحد، بل يشمل مؤسسات القطاع الخاص أيضا.
ولو اقتصر الفساد على المستويات الدنيا من الأجهزة والمؤسسات لهان الأمر، لكن أهم وأخطر عمليات وقضايا الفساد وراءها شخصيات كبرى ذات نفوذ، تمتلك في كثير من الأحيان القدرة وارتباطات لحماية نفسها من أن تطولها يد العدالة، ناهيك عن قصور النص الدستوري في ملاحقة من تثبت عليه التهمة.ولأن الديمقراطية تعني المساءلة والشفافية والمحاسبة، فإن رموز الفساد التي تسعى للحفاظ على قنواتها في النهب وتحقيق المصالح، تقف ضد التغيير الديمقراطي، وتدعم كل تراجع عن المكتسبات الديمقراطية. وفي الحقيقة، فإن مخاطر الفساد لا تتوقف عند حدود عرقلة العملية الديمقراطية، بل تتعداها إلى الحد من القدرة على السير المطرد في طريق الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة.
لا عودة إلى الوراء:
إن مظاهر التراجع عن الديمقراطية التي شهدها الأردن في الفترة 1993-1998، تمثل خسارة وطنية بكل تأكيد، لكنها لا تهدد بإلغاء المكتسبات الديمقراطية والعودة إلى ما قبل العام 1989، فقد كرست الديمقراطية مكاسب وحقائق جديدة، يمتلك الشعب كل المصلحة في الحفاظ عليها وتطويرها، فضلاً عن ذلك فإن الوضع الدولي يشكل عاملاً ضاغطاً لمواصلة السير في النهج الديمقراطي، وهو ما لا يستطيع الأردن الرسمي تجاهله.
لقد عاش ابناء الأردن فترات عصيبة فيعام 1998، بسبب مرض ثم رحيل الملك الحسين رحمه الله، لكــن الأردن أثبت أنه بلد حيوي، وأن تراثه الدستوري قد أمّن انتقالاً سلساً للمسؤوليات في رأس الدولة، ومّما أثار إعجاب العالم، ويتابع أبناء الأردن باهتمام مظاهر الانفتاح والإصلاح التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني، بما يعزز ثقتهم في مستقبل العملية الديمقراطية.
في هذا الاتجاه، فإننا نؤكد أن الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بانتقال الأردن إلى العصر الجديد؛ عصر الألفية الثالثة، وتتأكد أهمية ذلك في ضوء التطورات القادمة لعملية السلام على المنطقة، فمن الواضح أن هناك زخماً باتجاه حل النزاع العربي-الإسرائيلي سيتبلور بشكل محدد وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، وبالتالي فإن خريطة المنطقة السياسية ستتغير بشكل جذري، والمشاركة السورية المتوقعة في هذا الزخم سوف تساعد كذلك في تغيير تلك الخريطة السياسية، وسيكون لكل هذا انعكاسات هامة على الوضع الداخلي لا يستطيع الأردن تجاهلها، وبالذات في الموضوع الديمقراطي، وبشكل أوسع في موضوع إجراء التغيير والإصلاح في الدولة، فالمسارات الداخلية مترابطة، ولا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي من دون إصلاح إداري واجتماعي وسياسي، والعكس صحيح، والتحديات المقبلة؛ سواء على صعيد السياسية الإقليمية وارتباط الوضع الأردني بالوضع الفلسطيني، ستشكل عوامل ضغط قوية جداً، وعلى الأردن التعامل معها بسرعة وانفتاح ونظرة مستقبلية، و مفتاح التعامل مع هذه المتغيرات هو التحول الديمقراطي الحقيقي، وبناء مؤسسات المجتمع المدني بالمعنى الصحيح، للإمساك بزمام الأمور الداخلية.
على هذه الطريق فإنه لا بد من أن نبدأ من القاعدة، وتثقيف الناس وتحقيق مستلزمات البناء الديمقراطي، لاسيما على صعيد الأحزاب السياسية وتطوير النظام التعليمي وإقرار التشريعات الديموقراطية والتقدمية.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved