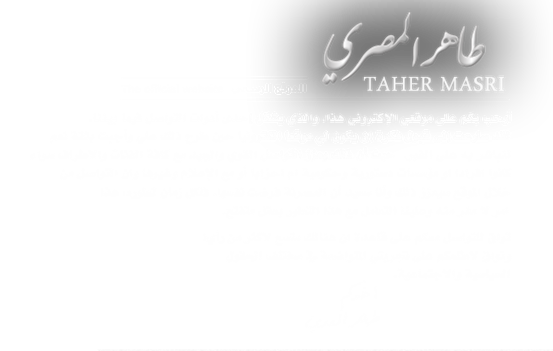

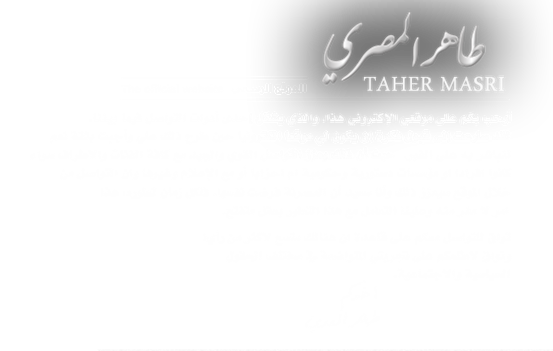

واقع الحياة السياسية في الأردن وتطلعات المستقبل
ألقيت هذه المحاضرة في 27/3/2000 بدعوة من منتدى شومان الثقافي، وأخذت هذه المحاضرة حيزاً كبيراً من النقاشات التي تلتها على مدى أسابيع لأهمية ما ورد فيها
أمران أحرص عليهما في حياتي: صداقتي وصراحتي، وإذا فرض علي يوماً أن اختار بينهما، فإنني أختار الصراحة، لأنها في تقديري هي التي تحمي الصداقة.
هـــذه المحاضرة تبحث عن الحاضر في الماضي، ولا تسعى لفهم الحاضر من الماضي، أقول هذا بمناسبة مرور سنة على بداية العهد الجديد، وأجدها مناسبة كي ندعو ونتطلع لبناء مستقبل مبني على أسس تحقيق العدالة وبناء الدولة الحديثة ومؤسسات المجتمع المدني الديمقراطي. وهي فرصة ذهبية للعهد الجديد لنقل الأردن والأردنيين من وضع داهمنا أواخر القرن الماضي وأبعدنا كثيراً عن صناعة الحدث في المنطقة، وأبقى المستقبل مجهول الاتجاه والعواقب لغاية الآن، وهي فرص متاحة لإعادة صياغة المجتمع الأردني ومفاهيمه وإدارته.
إن العالم من حولنا يتغير ويتقدم ويسبقنا، وأصبحت فسحة الوقت قصيرة، لذلك فلا بد من أن نفتح عقولنا وأن نقرر إجراء التغيير الحقيقي لا الشكلي، وإجراء الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري المتزامن ووفق نهج علمي يمتلك الرؤية الشمولية ويستند إلى المنطق والواقعية، فلا يمكن نجاح الإصلاح في المجال الاقتصادي دون إجراء إصلاح سياسي أو اجتماعي أو إداري.
تشير أنباء لقاء القمة التي عقدت أمس بين الرئيسين السوري والأمريكي، إلى عدم توصيلهما لإتفاق باستئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل قريباً، وإلى خلاف جذري في مواقف الطرفين، وهذا الأمر إن استمر سوف تكون له تداعيات هامة، وسيعقد كثيراً الوضع في المنطقة، خاصة في ضوء الالتزام الإسرائيلي بانسحابها من لبنان في شهر تموز القادم، وسوف يلقي بظلاله السياسية والأمنية على كل أطراف النزاع العربي الإسرائيلي، وعلى المنطقة بشكل عام، وأصبح واضحاً أن أي محاولة لفصل المسارين السوري واللبناني ستبوء بالفشل.
في ضوء هذه التطورات، سيكون من الصعب التكهن بمسار الأحداث خلال الأشهر القادمة، لكنني أستطيع القول إن هذا الفشل سوف يعطل أهداف إسرائيل في سعيها الحثيث للوصول إلى اتفاقية سلام بينها وبين سوريا ولبنان، إسرائيل تريد توقيع سلام مع سوريا ولبنان، لأنها تريد بذلك أن تنهي مرحلة كاملة من تاريخ المنطقة وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، لتصل إلى تحقيق أمر رئيسي سعت إليه في حرب عام 67 ولتبدأ مرحلة جديدة، لا بد أنها قد أعدت لها جيداً، كما أعدت لمراحل المشروع الصهيوني سابقاً ونفذتها بنجاح كبير، فأهداف إسرائيل من حرب حزيران كانت:
وبهذا تظن إسرائيل أنها قد سوت وضعها مع العرب بشكل تعاقدي وأبقت وضعها مع الفلسطينيين معلقاً لترتيبه بالشكل الذي يتفق مع عقيدتها، العقيدة اليهودية والبرنامج الصهيوني يؤمن أن كل فلسطين هي أرض دولة إسرائيل، إنها أرض الميعاد، ولم ولن يحدث أي تغيير أو تبديل على هذا المفهوم لديهم. وسيكون هدف المرحلة الجديدة القادمة لإسرائيل هو استيعاب باقي الأراضي الفلسطينية، وجوهر البرنامج سيكون التخلص من السكان الفلسطينيين وأهل الضفة الغربية بالذات، فتهويد الأرض هدف ممكن التحقيق، أما تهويد السكان العرب الفلسطينيين فهو هدف مستحيل، ولذلك فلابد من التخلص منهم للحفاظ على الهوية اليهودية للدولة، وما مفهوم الفصل السياسي الذي ينادي به باراك بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا مقدمة لذلك.
لقد ثبت أن لدى القائمين على العقيدة اليهودية والمشروع الصهيوني والدولة الإسرائيلية القدرة الكبيرة على التخطيط بعيد المدى،وعلى تنويع أساليب عملهم وأدوات التنفيذ، والإستفادة من تشتت العرب ومن نقاط ضعف الآخرين ومن نقاط قوتهم، ومن الشبكة الرهيبة التي أنشأتها الحركة الصهيونية لتمتد إلى كافة أنحاء العالم، والتي مكنتها من التشارك مع مراكز القوى الرئيسية خاصة في الولايات المتحدة وبعض دول العالم في مجالات السياسة والمال والاقتصاد والإعلام والنشر والتكنولوجيا وغيرها، لتحقيق مآربها وخططها، وإن أساليب ونتائج أعمال الحركة الصهيونية وإسرائيل منذ أكثر من مائة عام ماثلة اليوم على أرض الواقع.
وفي المقابل، فإن إسرائيل اليوم ليست في وضع مثالي بالرغم من أنها في وضع متقدم، فالمشكلات التي تواجهها داخلية، والحقائق المرتبطة بهذا الوضع، لا يمكن حذفها في سياق النظر إلى مستقبل إسرائيل ووضعها في المنطقة، وفي سياق مستقبل الصراع.
فالتناقضات الداخلية سوف تجعل وجود إسرائيل بحد ذاته في أزمة على المدى الطويل، فإسرائيل كيان أساسه ديني وتناقضاته قومية وطنية، ولذلك فعوامل تفجيره تكمن في داخله، مأزق إسرائيل هو أن شرعيتها في نظر جزء من مواطنيها نابعة من أًصلها وارتباطها الديني، ومن بنائها المؤسسي الديموقراطي في نظر الآخر من مواطنيها، وإذا ما تم تغليب الطابع الديني على الدولة ومؤسساتها، كما يطالب المتدينون، فإن ذلك سوف يلغي أساسها الديموقراطي، أما إذا تم تغليب الطابع العلماني والمؤسسة الديموقراطية كما يطالب العلمانيون، فإن ذلك سوف يلغي أساسها الديني، وفي كلتا الحالتين ورغم انتمائهما المشترك إلى الحركة الصهيونية ومشروعها الاستيطاني، ينظر كل من المتدينين والعلمانيين إلى بعضهما البعض على أن كلاً منهما يحاول سلب شرعية الدولة الإسرائيلية، وهو بالتالي يسلب أيضاَ شرعية فكره ووجوده. فالدين في إسرائيل يصبح في نظر المتدينين وطنية، بينما يرى العلمانيون أن الأساس الديموقراطي ومؤسساته هو عماد الوطنية.
هذا التناقض الكبير داخل إسرائيل أخذ أبعاداً هامة خلال الانتخابات الأخيرة، بقدر ما أخذ موضوع السلام مع العرب، وأًصبح اقتراب الصدام بين المتدينين الذين يحكمون قبضتهم داخل إسرائيل بشكل مستمر وبين العلمانيين، أمراً مطروقاً في الإعلام وبين النخبة السياسية والثقافية الإسرائيلية، وما نراه من إنشاء أحزاب سياسية تقوم على أساس إثني، مثل حزب شاس الديني ثالث الأحزاب الإسرائيلية الذي يعتبر حزباً مغربياً بشكل أساسي وحزب المهاجرين الروس العلماني، إلا أحد مظاهر هذا الصراع والاستقطاب الداخلي. وهؤلاء المهاجرون سيوقعون أُثراً هاماً في المجتمع الإسرائيلي لأن حوالي 20% منهم ليسوا يهوداً ويمارسون الشعائر المسيحية بشكل غير منتظم، كما أن نسبة عالية منهم تهاجر لإسرائيل للحصول على جواز السفر والانتقال بعدها إلى الولايات المتحدة بالذات ليستفيدوا من الميزات الكثيرة التي تمنح لحاملي جواز السفر الإسرائيلي.
وكما يواجه الأردن كل هذه المستجدات والتحديات والقضايا التي تطرحها المخططات والحلول الدولية والإقليمية وتداعيات الفشل أو النجاح على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية، فإنه يواجه أيضاً مشكلات وصعوبات الوضع الداخلي، وتراقب كل القوى الإقليمية والدولية الجبهة الداخلية في الأردن، وتعرف نقاط ضعفها الكثيرة، لتضعها في الحسبان عندما يأتي وقت التنفيذ والعمل، والجبهة الداخلية المتماسكة هي وحدها التي تصون الأردن ومصالحه وكيانه، وهي نقطة الانطلاق للأردن للتعامل مع المتغيرات والمعطيات والأحداث، وأي خطر يواجه الأردن لن يكون هذه الأيام باحتلال أجنبي أو اعتداء مسلح من الخارج، بل الخطر يأتي من الداخل، ومن تفاقم الأزمات والمشكلات الاقتصادية والسياسية وضعف تماسك نسيجه الاجتماعي والوطني واتساع المفاهيم الانعزالية بين فئاته السياسية والاجتماعية والسكانية ومن تفشي الأمراض الاجتماعية.
لا شك أن أزمة الحياة السياسية الأردنية هي مظهر رئيسي لتراجع مسيرة التجربة الديموقراطية ولمحاولات إعادة بناء العلاقات الوطنية، ولفشل عملية تغيير لواقع مؤسسات المجتمع والدولة، وبالرغم من أن أهم صور تلك الأزمة قد تمثل في عدم نمو وضعف وتراجع العمل الحزبي ومؤسساته، فإن أزمة الحياة السياسية أصبحت واقعاً اتسع ليصيب مختلف المؤسسات الشعبية والرسمية، بما في ذلك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حتى نكاد نقول بغياب الخطاب السياسي الرسمي، ناهيك عن الإجماع الوطني حول توجهات وأهداف وطنية عامة.
ولكن الإشكالية الأهم التي حسمت عملية تطور ونمو الحياة السياسية والحزبية في البلاد، هي تراجع العملية الديموقراطية بكاملها، أو ما نعبر عنه بأزمة التجرية الديموقراطية، وهي أزمة أكثر شمولاً وعمقاً وتأثيراً، بل إن أزمة الحياة السياسية والحزبية هي أحد اهم مظاهرها ونتائجها، وتلك حقيقة لم تعد تحتاج إلى براهين، وهي خيــار رسمي خاطىء تم اللجوء إليه، وتم تبنيه بعد أن عصفت بالعالم والمنطقة رياح التغيير، ووجد الأردن نفسه يتعامل مع واقع جديد يتمثل في نتائج حرب الخليج وفي التسوية السياسية واتفاقيات أوسلو ووادي عربة وشروط العولمة السياسية والاقتصادية، وبهذا الخيار أصبحت الصورة الإيجابية التي يعكسها جلالة الملك في المحافل الدولية وتحديده للأولويات الصحيحة، لا تتناسب مع الممارسات والسياسات التي يتم التعامل معها في الداخل، وكل من زار الأردن من عرب وأجانب، سياسيين أو مستثمر ينظهر له ذلك التناقض جلياً، وأصبح واضحاً أن هناك تناقضاً بين السياسات والتوجهات الخارجية وانعكاساتها ومتطلباتها وبين النهج والسياسات والممارسات الداخلية.
لقد أدى ذلك كله لوجود اختلالات عديدة، وأدى إلى إفراغ مفاهيم الديموقراطية والتعددية والمشاركة من مضامينها بشكل فاق كل التوقعات، وأصبح من الضروري إعادة تقييم كل ما تم والقيام بثورة في المفاهيم. وأرى أن علينا القيام بما يلي:
أولاً: تحظى نقطة البداية بأهمية خاصة في الفكر والفعل السياسي، نظراً لما لها من تأثير بالغ على الرؤية الإستراتيجية لمسيرة الوطن، ربما لهذا السبب يجهد السياسيون على الدوام في ترتيب أولويات عملهم، وإيلائها عناية فائقة، انطلاقاً من أن الدقة في تنظيم الأولــــويات وترتيبها وفق الظروف المناسبة، تشكل أول ضمانات النجاح في تحقيق الأهداف، من هنا ينبع اهتمامنا بنقطة البداية الأردنية ورؤية المحيط والعمق العربي وموضوع التكامل أو حتى التنسيق الاقتصادي، وفي رأيي فإن من الأولويات أن يسعى الأردن بشكل حثيث وجدي وسريع، وبعيداً عن أية حساسيات أو ترسبات ماضية، لإيجاد التكامل الاقتصادي أولاً مع كل من سوريا ولبنان وفلسطين.تمهيداً لتوسيع صيغة هذا التكامل في نواحٍ أخرى، بما فيها المجال السياسي في وقت لاحق ومناسب تقرره كافة الأطراف، حتى يستطيع الأردن أن يقيـــم علاقات إقليمية متوازنة في ظل التسوية السياسية التي تفرض تعاملاً مع كل دول المنطقة، إضافة إلى ذلك فإن الأردن يستقوي بالتكامل مع سوريا ولبنانعلى التغول الإسرائيلي الذي يداهمنا بشكل واضح، نقطة البداية سوف تشكل خط السير وتقود إلى دائرة النهاية التي ستوثر إيجاباً على المستقبل الأردني سيادة وكياناً لعشرات الأعوام القادمة، وأولى بنا أن نضع نفس الجهد والتنسيق السياسي والأمني الإستراتيجي الذي نبذله مع إسرائيل وتركياعلى نفس المستوى على الأقل مع بلدان عربية مثل سوريا ولبنان، وإلا فإن مفهوم الشرق الأوسط الجديد سوف يطغى على شعارنا الذي رفعناه حول أولوية ارتباطنا بالبعد العربي.
إن هــــذا الأمر أصبح ملحاً في ضوء ضعف جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، والأردن أكثر من أي بلد عربي يتضرر من ترسيخ القطرية وربط مصالحه مع دول أجنبية بعيدة أو قريبة عنا، وهــو أكثر من أي بلد عربي استفادة وحاجة للالتحام مع جيرانه وأشقائه أقطار سوريا الطبيعة. ولا بد من أن ندفع إلى صدر أولوياتنا مصلحة الأقطار الأربع في التعبير المؤسسي الاقتصادي أولاً والسياسي ثانياُ عن الروابط والمصالح المشتركة الجامعة لهم جميعاً، ابتداء من إزالة الحواجز الاقتصادية وإعادة البنية الهيكلية للسوق المشتركة، وانتهاء بصيغة أو بأخرى من صيغ الاتحاد السياسي، وإدخال فلسطين في هذه الصيغة، يجب أن يتم في التوقيت المناسب وبعد اتضاح شكل ونوع وجدية الاتفاق السياسي بين إسرائيل وفلسطين، وهو ما يمهد فيما أعتقد للحل القومي الأسلم وهو وحدة أقطار سوريا الطبيعية والعراق.
إن التعامل مع هذه الأفكار سيكون أسهل في ظل التغيير السياسي المرتقب في سوريا، ولا أظن أنها سوف تثير حساسيات كبيرة مع باقي الأشقاء العرب، ولا تعتبر محوراً عربياً في مقابل دول عربية أخرى، كما يقال، بل هي طبيعة الأمور، فالعالم من حولنا يتجمع ويتكتل على أساس اقتصادي أولاً، لأن الدولة الوطنية أصبحت لا تستطيع وحدها تلبية احتياجات مواطنيها، وحلم الوحدة العربية الشاملة أصبح بعيد المنال، والحل الواقعي الأكثر منالاً هو في تحقيق تكامل داخل كل إقليم عربي، يمهد ويقوي إقامة نظام عربي إقليمي موحد.
ثانياُ: لا بد من تفعيل المبدأ الدستوري الذي يعطي الولاية العامة لإدارة شؤون الدولة لمجلس الوزرء وممارسته بشكل كامل، لقد تراجعت مؤسسة الرئاسة لصالح سلطات وجهات أخرى وأصبحت هيئة الوزارة حالة وظيفية لا حالة سياسية، والقرار السياسي يجب أن يبقى دائماً في يد السلطات والمؤسسات المدنية، إذ تعددت المرجعيات للمسؤول والمواطن على حد سواء، وأصبح القرار في كثير من الحالات بما فيها القرار السياسي، لا يتخذ داخل مجلس الوزراء، بل في أطر أخرى، وأصبحت المهمة الأولى للــــوزراء هي إدارة شؤون وزاراتهم فحسب، أي أن الوزير أصبحومنذ زمن هو كبير موظفي تلك الوزارة، وأصبح الأمناء العامون للوزارات وكبار موظفي الجهاز الحكومي هم أقرب الناس للوصول إلى المنصب الوزاري، كلامي هذا لا ينفي ضرورة الاستعانة بوزراء فنيين فهناك دائماً حاجة لهم، معنى كلامي هو أن تستقر الوزارات وأن تمارس صلاحياتها الدستورية بالمعنى السياسي الحقيقي والمتعارف عليه وأن تنضوي كافة أجهزة الدولة بكل تسمياتها ومهامها وقدراتها تحت مظلة مجلس الوزراء، لتنفذ سياسات الدولة وليس العكس فهذه من أساسيات المجتمع المدني والديموقراطي التي نؤمن بها جميعاً.
وفي هذا السياق، فقد أصبح أمر أهلية القضاء الأردني موضع شك ونقاش علني، وبات من المألوف أن نسمع ونقرأ من بعض قضاته الكبار انتقادات خطيرة عن عدم نزاهة القضاء، بل فساده.ومهما يكن من خلفيات هذا الطرح، فقد بدأت تظهر للعلن صورة سلبية عن مرفق أساسي من مرافق وأعمدة الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه مفهوم العدالة وتحقيقها في أذهان المواطنين، فالعدالة وتحقيقها جوهر دولة القانون بل جوهر كيان أي دولة، وإذا انهار مفهوم العدالة تنهار الدولة معها، وإذا كنا نسعى لإنشاء دولة القانون فعلينا رفع سوية ومستوى مؤسساتها وأولها القضاء.
ثالثاً: لا بد لي من تكرار أمر تحدثت به كثيراً خلال السنة الماضية وهو مفهوم الدولة، لقد ظهرت ممارسات خلال السنوات القليلة الماضية تقزم معنى ومفهوم الدولة، ليصبح مفهومها محسوباً وممارساً من خلال مصالح ضيقة سواء أكانت شخصية أو عشائرية أو إقليمية أو جهوية، ومن خلال ولاءات لا تسمح بأي هامش من التعبيرعن الرأي أو الاختلاف فيه، كما تراجع مفهوم الشعب ليصبح المفهوم تعاملاً مع السكان. وأصبح الشعب في خدمة الحكومة بينما الأمر الطبيعي هو عكس ذلك، والتعامل مع الدولة ومع الشعب من خلال هذه المفاهيم المقلوبة والبدائية ومن هذه الزاوية الضيقة يؤدي بإستمرار إلى شرذمة المجتمــع وإلــى إضعاف الجهد الوطني بشكل عام، ويجعل المواطن عرضة للخوف والشك وعدم الاستقرار، وهذا هو حالنا اليوم،إذ يكون بإمكان أعداء الأردن النفاذ من نقطة الضعف هذه في الوقت المناسب، إذا أرادوا الإضرار بنا.ومعياري في قياس مدى الانتماء للوطن ينطلق من هذه النقطة بالذات، مدى فهم والتزام المسؤول والمواطن بمفهوم الدولة والشعب الحقيقي.
وبسبب هذا الخلل الكبير، حصل هذا الاستشراء الكبير والعميق للفساد وأصبح للفاسدين والمفسدين هذه الامتيازات التي نراهم يتمتعون بها، وبسبب ذلك تناسلت الشخصية الفهلوية الوصولية تناسلاً تكاثرياً مرضياً، وبسبب ذلك انحدرت فعالية وإنتاجية الجهاز الإداري إلى مستويات متدنية، وما ذلك التبجح الكاذب بالوطنية والشعارات الفارغة من أي مضمون حقيقي إلا تغطية على أعمالهم وعلى مصالحهم الشخصية.وبسبب ذلك ضعفت مؤسسات وهيئات وتنظيمات المجتمع المدني السياسية والاقتصاديـــة والمهنية والثقافية والاجتماعية وظهرت كل أنواع العصبيات البغيضة داخل المجتمع الأردني.
رابعاً: إن بناء الحياة الراقية في المجتمع الحر الناهض، يقوم على الحقائق العقلية وليس على الأوهام والأضاليل، وتؤكد الحقيقة الإنسانية الشاملة فضلاً عن معطيات علم الاجتماع ونشوء الأمم وعشرات الحقائق التاريخية والجغرافية والفكرية والنفسية والأمنية، أن الجماعة البشرية على شطري نهر الأردن كانوا عبر القرون الطويلة، ولم يزالوا، شعباً واحداً يجمع ما بين جهاته الأربعة الاشتراك في وحدة الحياة ووحدة المصير، وشكل هذا التجمع عبر التاريخاتحاداً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، تسوده درجة عالية من التجانس العرقي والثقافي والديني وحتى المذهبي الضيق، ولم يكن لأي منهما أي مدلول سياسي مستقل حتى أوائل العشرينات من القرن الماضي.
وكانت تجزئة الشعب الواحد هي الوسيلة التي قصد بها تكريس حالة الضعف لجميع الكيانات المستحدثة، بقصد التمهيد لإقامة إسرائيل وتشتيت جهود المقاومة للمشروع الصهيوني، ولم ينقطع الشرق أردني يوماً عن الاعتقاد بأن فلسطين جزء منه مثلما أنه جزء منها، وأمد الثوار بمختلف اشكال الدعم سلاحاً ومالاً وإيواء، لهذا كانت الوحدة بين الأردن وما تبقى من فلسطين بعد عام 1948 أول تمرد حقيقي على حدود سايكس بيكو، وبغض النظر عن ظروفها ودوافعها، كانت الوحدة بمثابة العودة بالناس والأرض على جانبي النهر إلى واقعها الطبيعي الحياتي الأصيل.
لقد تشكلت الوطنية الأردنية من اتصال جغرافي وسكاني حميم بين الضفتين عبر أجيال كثيرة، ومن اندماج أردني فلسطيني عقب الوحدة، وبغض النظر عن أي سلبيات تمت أثناء الوحدة أو بعدها، فقد أصبح الأمر حقيقة لا يمكن إنكارها أو التراجع عنها، ولا تخلو دولة من اختلاف وتفاوت بين الفئات والشرائح والطبقات والمكونة للسكان والمجتمع، وهو ما يسمى بظاهرة التعددية المجتمعية، ويعتمد استقرار الدولة وأمنها وازدهارها الاقتصادي إلى حد بعيد على الطريق التي تدير بها الدولة تلك التعددية وتتوحد في إطارها.
وللأسف الشديد فقد كانت الإدارة الرسمية لهذه التعددية المجتمعية ذات أبعاد سلبية وعميقة، فسياسة الوظائف والتوظيف التي قامت على المزاجية والشخصنة والجهوية بدت وكأنها سياسة إقصاء متـــدرج لعدة عقود، ولم تنتج إلا الشعور بالتفرقة وانعدام العدالة، وخلق الاختلالات والتراجع الاقتصادي، وإثارة العصبيات الجزئية المفتتة لوحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي، وبدت هذه السياسة وكأنها أكثر من ظاهرة مزاجية وسوء إدارة، بل أصبحت بفعل تنامي المصالح والإفساد الفكري والسياسي وعلنية الاتجاهات الإقليمية، أسلحة تآمر وتفتيت يثيرها من لا يريد بالشعب والوطن خيراً، وفي سنوات لاحقة أصبحت ذريعة رفض التوطين مدخلاً للاعتراض على مبدأ المواطنة.
وعلى النقيض من سياسة الإقصاء، فإن نهج المشاركة للجميع والحوار والتواصل يحصن المجتمعات ويحميها، وجوهر المسألة الإقليمية في هذا البلد أصبح مسألة مواطن حر واع ونظيف مقابل مواطن مريض مسكون بالعقد الموروثة والمستحدثة، مخدوع بالأوهام والأضاليل، لذلك فإنني من المؤمنين بأن مطالب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لبرامج التنمية على مساحات الوطن الأردني ومحافظاته وفئاته، هي أهداف عامة وأساسية لأي برنامج وطني يمثل طموحات الشعب الأردني ووحدته.
خامساً: إن المجتمع والقانون والسلطة، ثلاثة معطيات إنسانية متلازمة الوجود ومتقابلة التأثير بعضها تجاه بعض.وموضوع سيادة القانون يمثل حقيقة وطبيعة الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفاعلة والمتفاعلة في أي مجتمع في مرحلة معينة، ولكي تكون سيادة القانون حائزة على عناصر وجودها كاملة، تستوجب خضوع الهيئات الحاكمة إلى جانب الأفراد للقانون، هذا أمر حيوي لا يجب التغاضي عنه أو التلاعب بمفهومه.
إضافــــــة إلى ذلك فإن حجم الأردن ومحدودية موارده، والتحديات السياسية والاقتصادية المستمرة، يجعل قابلية استمرار نجاحه ونموه الاقتصادي والحضاري رهناً بتفوقه النوعي، ولعل على رأس الأولويات لتحقيق ذلك هو المجتمع المدني الديموقراطي الذي يتساوي فيه المواطنون ليس فقط في نظر القانون، بل وفي نظر المسؤولين وموظفي الدولة والأجهزة التي تنفذ القانون، ويقتضي ذلك تغييراً جدياً في ممارساتها والعمل على إعادة التوازن والتكافؤ والإحساس بالمساواة عند قطاعات كبيرة من الأردنيين غاب عنها هذا الإحساس مدة طويلة، وأعني بالتمييز هنا كافة أشكاله وكافة دوافعه الجهوية والطائفية والسياسية.
إن المهمات التي يشتمل عليها التنفيذ الفعلي والأمين لمبادىء المجتمع المدني الديموقراطي ليست سهلة، إذا أخذنا بالاعتبار ترسيخ الاستقطاب للولاءات الشخصية والفئوية داخل المجتمع خاصة في الدوائر الرسمية، الذي تراكمت حوله وارتبطت به باستمرار مصالح مكتسبة ومراكز قوة سلبية سوف تحارب بعناد لإحباط ذلك التنفيذ الفعلي والأمين، لكن الانتصار في هذه المواجهة هو من الأهمية بمكان، الأمر الذي يتطلب الإقدام على عدد من الإجراءات التي ترسخ التوجهات والقواعد الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الديموقراطي المدني، وعلى رأس هذه الإجراءات إصدار قانون الانتخابات النيابية بحيث يكون عصرياً وبعكس روح المجتمع وتركيبته على أسس عادلة ومتساوية ويتيح المجال أمام بروز قيادات تمثل اتجاهات وخيارات المجتمع الأردني الوطنية.
كما أصبح من الضروري إعادة النظر من قبل الأجهزة الأمنية كافة في الأسس والمعايير التي تتعامل بها هذه الأجهزة مع المعطيات الأمنية، وبالتالي مع المواطنينوفي تقديري، فإن الظروف السياسية والأمنية التي رتبت مثل هذه الأسس والمعايير في المراحل السابقة قد انتهت إلى غير رجعة، ومما يجعل هذا التطوير سهلاً ومواتياً، هو اتساق ذلك مع سمات المجتمع المدني الديموقراطي الذي ننادي بتحقيقه على رؤؤس الأشهاد، وفي قناعتي أنه سيكون لهذا التطور المقترح مردود إيجابي بالغ في قلوب المواطنين قاطبة وتقوية مشاعر المواطنة والانتماء لديهم، لأن الأمن الوطني الحقيقي يؤمنه العقد الاجتماعي الذي يحقق الحرية والعدالة والمشاركة، ويحول أمن الوطن وحمايته واستقراره إلى مهمة مركزية للجميع.
إن المخاطر الأمنية التي نتحسب منها لم تعد نابعة من الفئات أو الدوافع والأهداف السياسية أو بسببها، بل هي تتأتى من عناصر اجتماعية واقتصادية ضاغطة على عنق المواطن منذ سنوات، فمكامن الخطر القادم يأتي من التفريغ المتعمد للحياة السياسية، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني والحركة الشعبية، وانحدار مستوى معيشة الناس، وازدياد مساحات الفقر والبطالة، وازدياد الصراع الطبقي نتيجة للأوضاع الاقتصادية، وارتفاع وتيرة الشللية والجهوية والإقليمية، وهي كلها عوامل ومظاهر متفجرة تدفع بالناس إلى التطرف والابتعاد عن الحوار والاعتدال والوسطية.وعلى الفهم الأمني أن يدرك تلك الحقائق وهذه المتغيرات، ومن الضروري أن يبقى مفهوم الأمن الوطني بمعناه الواسع والشامل، ليعمل على توحيد الوطن بكل مكوناته ومؤسسات واتجاهاته السياسية وفئاته الاجتماعيـــة، وأن يكون خاضعاً لخيار الديموقراطية والتعددية والمشاركة والعدالة والمساواة، ولا يخضعها له. وانه ليقلقني حقاً وقوع أي خلل على هذا المفهوم.
إنّ ما قلته اليوم، لا أهْدِف من ورائه إلا نيل موافقة الجميع عليه كله، بل ليكون أرضية قرار وطني هادف يعتمد على إجماعنا بأننا نعاني من التراجع والتردي والتفسخ، لذلك توجب علينا أن نتصدى لها أمس قبل اليوم، ودعونا نتفق بأن أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير والتطوير، وفي استتباب سيادة القانون وإعلاء شأن الديموقراطية هم سواد الشعب الأردني، وأن الذين يقفون في وجه ذلك هم قلة قليلة لكــن المؤسف أن هذه القلة قد انتظمت، وتحمي مصالحها عبر شلل تتشكل بانتظام هنا وهناك. وفي المقابل، فإن أصحاب الحق وأصحاب المصلحة في الوطن متفرقون متشرذمون، تباعد بينهم ألاعيب الفئة الظالمة، تدس بينهم وعليهم.
وقد آن الآوان أن ينتظم هؤلاء في تيار وطني عقلاني عريض، يمثل الاتجاه الديموقراطي العروبي التقدمي بمفهومه الواسع الذي يستند إلى مبادىء وقيم الميثاق الوطني، وإلى قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، والدفاع عن حرية الرأي، وإلى معايير النزاهة والأمانة والصدق، يؤمن ببناء المؤسسات ودورها ويسعى إلى ترسيخ المعنى الشامل للدولة.
دعونا أيها الأخوة نضع أيدينا مع بعض وننسى فرديتنا وهواجسنا بل ومصالحنا الذاتية، لنبني تياراً يعمل لصالح وطننا ومستقبل أبنائنا، ويضع نصب عينه الوطن أولاً والوطن ثانياً والوطن أخيراً، لأنه كلما كان الوطن بخير سنكون جميعاً بألف خير، دعونا نبدأ حواراً وطنياً هادفاً لا تبادل فيه للاتهامات أو التعامل مع ردود الأفعال أو التمترس وراء شعارات فارغة.
آن الآوان أن نضع الموقف والرأي والمطالب في إطار عمل جماعي منظم وفاعل، يفرض وجوده واحترامه ومشاركته، وينهي حالة الاحتجاج السلبي والفردي التي لا أثر لها ولا دور، بـــإستثناء التنفيس عن الاحتقان، وزيادة الشعور باليأس وعدم الجدوى والاتكالية، وتعميق حالة الفراغ السياسي وما تحمله من مخاطر لعودة عقليات ومفاهيم التناقض وممارسات العنف السياسي والاجتماعي.
علينا جميعاً أن ندلي برأينا في قضايا الوطن، وندفع الصوت دون أن نسمح لإنسان أن يشكك في صدق الانتماء والوطنية ونبل الأهداف، لقد انتظرنا طويلاً لنرى الدولة الحديثة تتكون، وأن تعم سيادة القانون، وأن نقوم النسيج الاجتماعي، وفي ظننا أن الأساليب ستتغير، وأننا سوف نتعامل مع قوانين تستجيب للمطالب وتحفظ الكرامة، وتحمي من الاستغلال ومراكز القوة السلبية والشللية والفساد، وتضع المواطنين سواسية أمام الحق والواجب.
ولا بد لنا من القيام بدورنا في إعداد وبناء قاعدة التعامل مع المستقبل، وهي مهمة تحتاج منا إلى التجديد والانفتاح وبذل الجهود المخلصة حتى نتواصل مع الأجيال الجديدة القادمة، والتي يصعب دون مشاركتها الحديث عن عمل سياسي نوعي جديد.
ختاماً، فإنني أرجو أن أكون قد قدمت في هذه المحاضرة مدخلاً للحوار ومساهمة عملية في البحث الوطني عن حلول لما نعيشه من تحديات وصعوبات.
Term of use | Privacy Policy | Disclaimer | Accessibility Help | RSS
eMail: info@tahermasri.com Tel: 00962 65900000
Copyright @ 2015 Taher AlMasri the official web site, All Right Reserved